زبدة التفاسير الجزء ٣
 0%
0%
 مؤلف: فتح الله بن شكر الله الشريف الكاشاني
مؤلف: فتح الله بن شكر الله الشريف الكاشاني
الناشر: مؤسسة المعارف الاسلامية
تصنيف: تفسير القرآن
ISBN: 964-7777-05-1
الصفحات: 637
 0%
0%
 مؤلف: فتح الله بن شكر الله الشريف الكاشاني
مؤلف: فتح الله بن شكر الله الشريف الكاشاني
الناشر: مؤسسة المعارف الاسلامية
تصنيف: تفسير القرآن
ISBN: 964-7777-05-1
الصفحات: 637

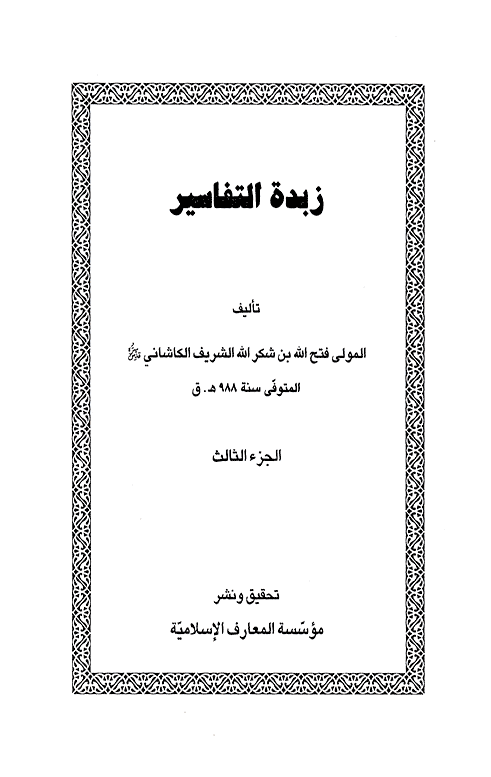
ملاحظة
هذا الكتاب
نشر الكترونياً وأخرج فنِيّاً برعاية وإشراف
شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي
وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً
قسم اللجنة العلميّة في الشبكة
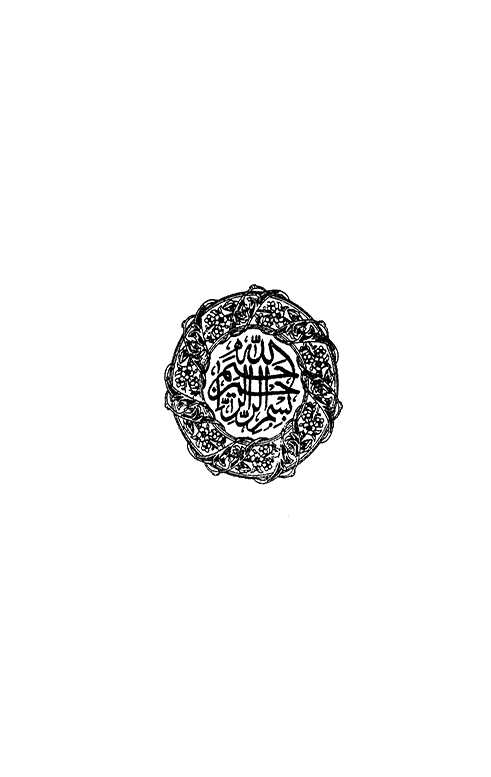
(٨)
سورة الأنفال
سورة الأنفال مدنيّة. وآيها خمس وسبعون.
وفي خبر أُبيٍّ عن النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم : «من قرأ سورة الأنفال وبراءة فأنا شفيع له، وشاهد يوم القيامة أنّه بريء من النفاق، وأعطي من الأجر بعدد كلّ منافق ومنافقة، في دار الدنيا عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيّئات، ورفع له عشر درجات، وكان العرش وحملته يصلّون عليه أيّام حياته في الدنيا».
وعن الصادقعليهالسلام : «من قرأهما في كلّ شهر لم يدخله نفاق أبدا، وكان من شيعة أمير المؤمنينعليهالسلام حقّا، ويأكل يوم القيامة من موائد الجنّة معهم، حتّى يفرغ الناس من الحساب».
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١) )
ولـمّا قصّ الله سبحانه في سورة الأعراف قصص الأنبياء وختمها بذكر
نبيّناصلىاللهعليهوآلهوسلم ، افتتح سورة الأنفال بذكره، ثمّ ذكر ما جرى بينه وبين قومه، فقال:( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يَسْئَلُونَكَ ) أي: يسألك يا محمّد جماعة من أصحابك( عَنِ الْأَنْفالِ ) أي: عن حكمها.
واختلف في الأنفال ما هي؟ فقال ابن عبّاس وجماعة: إنّها غنيمة بدر. وقال قوم: هي أنفال السرايا. وقيل: هي ما شذّ عن المشركين من عبد وجارية من غير قتال. وقال قوم: هو الخمس.
والصحيح ما قال الباقر والصادقعليهماالسلام : إنّها كلّ ما أخذ من دار الحرب بغير قتال، وكلّ أرض انجلى أهلها عنها بغير قتال أيضا، ويسمّيها الفقهاء فيئا، والأرضون الموات، والآجام، وبطون الأودية، وقطائع الملوك إذا لم تكن مغصوبة، وميراث من لا وارث له.
( قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ) ولمن قام مقامه بعده من الأئمّة المعصومين صلوات الله عليهم، يصرفونها حيث شاؤا من مصالحهم ومصالح عيالهم. وقالاعليهماالسلام : «إنّ غنائم بدر كانت للنبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم خاصّة، فقسّمها بينهم تفضّلا منهصلىاللهعليهوآلهوسلم ».
وهو مذهب أصحابنا الإماميّة. ويؤيّده أنّ الأنفال جمع نفل، وهي الزيادة على الشيء، سمّي به لكونه زائدا على الغنيمة، كما سمّيت النافلة نافلة لزيادتها على الفرض، وسمّي ولد الولد نافلة لزيادته على الأولاد. وقيل: سمّيت النافلة نفلا، لأنّ هذه الأمّة فضّلت بها على سائر الأمم.
واختلفوا في نسخ هذه الآية، فقال جماعة من المفسّرين: نعم، نسخت بآية( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ) (١) الآية. وقال الطبري(٢) وأصحابنا: ليست منسوخة. وهو الحقّ، لعدم المنافاة بينها وبين آية الخمس، لـما ذكرنا من المغايرة بين الموضوعين.
__________________
(١) الأنفال: ٤١.
(٢) تفسير الطبري ٩: ١١٩.
وقال سعيد بن المسيّب وجماعة: لا نفل بعد الرسولصلىاللهعليهوآلهوسلم . ومنعه جماعة من الفقهاء وأصحابنا، لـما بيّنّا أنّها للإمام القائم مقامه.
وفائدة الجمع بين الله ورسولهصلىاللهعليهوآلهوسلم كفائدته في قوله:( فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ) (١) على وجه يأتي إن شاء الله. فالمعنى: حكمها مختصّ بالله تعالى ورسوله. وتخصيصها علم بفعل الرسول، فإنّ فعله حجّة كقوله. وفي الكشّاف(٢) : أنّ حكمها مختصّ بهما، الله حاكم، والرسول منفذ.
عن ابن عبّاس: أنّ رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم قال يوم بدر: من فعل كذا فله كذا.
فتسارع الشبّان فقتلوا سبعين وأسروا سبعين، ثمّ طلبوا نفلهم، وبقي الشيوخ والوجوه تحت الرايات. فلمّا كانت الغنيمة جاء الشبّان يطلبون نفلهم. فقال الشيوخ: لا تستأثروا علينا، فإنّا كنّا ردءا، أي: عونا لكم، ولو وقعت عليكم الهزيمة لرجعتم إلينا. وجرى التشاجر بينهم، فنزلت. فقسّم رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم النفل بينهم بالسويّة.
وعن سعد بن أبي وقّاص: قتل أخي عمير يوم بدر، فقتلت به سعيد بن العاص، وأخذت سيفه فأعجبني، فجئت به إلى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقلت له: إنّ الله قد شفى صدري من المشركين، فهب لي هذا السيف. فقال: ليس لي هذا ولا لك. فما جاوزت إلّا قليلا حتّى جاءني رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم وقد أنزلت سورة الأنفال، فقال: يا سعد إنّك سألتني السيف وليس لي، وإنّه قد صار لي، فاذهب فخذه.
وقال عبادة بن الصامت: اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا، فنزعه الله من أيدينا فجعله لرسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقسّمه بيننا على السواء.
فخاطبنا بقوله:( فَاتَّقُوا اللهَ ) في الاختلاف والمشاجرة في الأنفال( وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ ) الحال
__________________
(١) الأنفال: ٤١، وسيأتي تفسيرها في ص: ٤٢.
(٢) الكشّاف ٢: ١٩٥.
الّتي بينكم من المنازعة بالمحابّة والائتلاف، والمساعدة والمواساة فيما رزقكم الله تعالى، وتسليم أمره إلى الله والرسول.
وقال الزّجاج: «ذات بينكم» أي: حقيقة وصلكم، ومنه:( لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ) (١) أي: وصلكم واجتماعكم على أوامر الله.
( وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ ) فيه( إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ) فإنّ الإيمان يقتضي ذلك.
أو إن كنتم كاملي الإيمان، فإنّ كمال الايمان بطاعة الأوامر، والاتّقاء عن المعاصي، وإصلاح ذات البين بالعدل والإحسان.
( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٢) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (٣) أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٤) كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ (٥) يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ ما تَبَيَّنَ كَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (٦) )
ثمّ بيّن صفة خلّص المؤمنين بقوله:( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ) أي: الكاملون في الإيمان( الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللهُ ) ذكر عندهم عقوبته وعدله، ووعيده على المعاصي بالعقاب، واقتداره عليه( وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ) فزعت لذكره تهيّبا من جلاله، واستعظاما
__________________
(١) الأنعام: ٩٤.
له. وأمّا إذا ذكرت نعمة الله على عباده، وإحسانه إليهم، وفضله ورحمته عليهم، وثوابه على الطاعات، اطمأنّت قلوبهم، كما قال تعالى:( أَلا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ) (١) ، وسكنت نفوسهم إلى عفو الله، فلا تنافي بين الآيتين.
وقيل: هو الرجل يهمّ بمعصية فيقال له: إتّق الله، فينزع عنها خوفا من عقابه.
( وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً ) لزيادة المؤمن به، أي: ازدادوا يقينا وطمأنينة نفس وتصديقا بها، منضمّا إلى يقينهم بما أنزل قبل ذلك من القرآن، كما روي عن ابن عبّاس أنّ المعنى زادتهم تصديقا مع تصديقهم بما أنزل إليهم قبل ذلك. يعني: أنّهم يصدّقون بالأولى والثانية والثالثة، وهكذا فكلّ ما يأتي من عند الله فيزداد تصديقهم كميّة لا كيفيّة، لأنّ الإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان عندنا.
وقيل: إنّ المراد ازدياد الايمان، لاطمئنان النفس ورسوخ اليقين بتظاهر الأدلّة، أو بالعمل بموجبها. وهو قول من قال: إنّ الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بناء على أنّ العمل داخل فيه.
( وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ) يفوّضون إليه أمورهم، ولا يخشون ولا يرجون إلّا إيّاه.
( الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ ) إنّما خصّ فرض الصلاة والزكاة بالذكر لعظم شأنهما، وتأكّد الأمر فيهما.
( أُولئِكَ ) المستجمعون لهذه الخصال الحميدة( هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ) هم الّذين استحقّوا إطلاق اسم الإيمان حقيقة عليهم، لأنّهم حقّقوا إيمانهم، بأن ضمّوا
__________________
(١) الرّعد: ٢٨.
إليه مكارم أعمال القلوب، من الخشية والإخلاص والتوكّل، ومحاسن أفعال الجوارح الّتي هي المعيار عليها، من الصّلاة والصدقة. و «حقّا» صفة مصدر محذوف، أي: إيمانا حقّا. أو مصدر مؤكّد للجملة الّتي هي( أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ ) كما تقول: هو عبد الله حقّا، أي: حقّ ذلك حقّا.
( لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ) شرف وكرامة وعلوّ منزلة. وقيل: درجات الجنّة يرتقونها بأعمالهم.( وَمَغْفِرَةٌ ) وتجاوز لـما فرط منهم من السيّئات( وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ) أي: حظّ عظيم أعدّ لهم فيها على سبيل التعظيم لا ينقطع عدده، ولا ينتهي أمده. وهذا معنى الثواب.
( كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ ) الكاف في محلّ الرفع على أنّه خبر مبتدأ محذوف، تقديره: هذه الحال كحال إخراجك. والمعنى: أنّ حالهم في كراهة ما حكم الله في الأنفال، مثل حالهم في كراهة خروجك من بيتك للحرب.
ويجوز أن يكون في محلّ النصب، على أنّه صفة لمصدر الفعل المقّدر في قوله:( الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ) أي: الأنفال استقرّت لله والرسول وثبتت مع كراهتهم، ثباتا مثل ثبات إخراج ربّك إيّاك من بيتك مع كراهتهم، يعني: من المدينة، لأنّها مهاجره ومسكنه، أو بيته فيها.
( بِالْحَقِ ) أي: إخراجا ملتبسا بالحكمة والصواب الّذي لا محيد عنه.
وسبب كراهتهم أنّ عير قريش أقبلت من الشام وفيها تجارة عظيمة، ومعها أربعون راكبا، منهم أبو سفيان وعمرو بن العاص وعمرو بن هشام، فأخبر جبرئيل رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ، فأخبر المسلمين، فأعجبهم تلقّي العير، لكثرة المال وقلّة الرجال.
فلمّا خرجوا بلغ أهل مكّة خروجهم، فنادى أبو جهل فوق الكعبة: يا أهل
مكّة النجاء(١) النجاء على كلّ صعب وذلول، عيركم أموالكم، إن أصابها محمد لن تفلحوا بعدها أبدا.
وقد رأت عاتكة أخت العبّاس بن عبد المطّلب رؤيا قبل ذلك بثلاث ليال، فقالت لأخيها: إنّي رأيت عجبا، رأيت كأنّ ملكا نزل من السماء فأخذ صخرة من الجبل ثمّ حلق(٢) بها، فلم يبق بيت من بيوت مكّة إلّا اصابه حجر من تلك الصخرة. فحدّث بها العبّاس، فقال أبو جهل: ما يرضى رجالهم أن يتنبّئوا حتّى تتنبّأ نساؤهم. وبرواية أخرى قال: هذه نبيّة ثانية من بني عبد المطّلب.
فخرج أبو جهل بجميع أهل مكّة، وهم النفير في المثل السائر: لا في العير ولا في النفير. فقيل له: إنّ العير أخذت طريق الساحل ونجت، فارجع بالناس إلى مكّة. فقال: لا والله لا يكون ذلك أبدا حتّى ننحر الجزور، ونشرب الخمور، ونقيم القينات(٣) والمعازف ببدر، فيتسامع جميع العرب بمخرجنا، وإنّ محمّدا لم يصب العير، وإنّا قد أعضضناه(٤) . فمضى بهم إلى بدر. وبدر ماء كانت العرب تجتمع فيه لسوقهم يوما في السنة.
ونزل جبرئيل فقال: يا محمّد إنّ الله وعدكم إحدى الطائفتين: إمّا العير وإمّا قريشا. فاستشار النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم أصحابه وقال: ما تقولون: إنّ القوم قد خرجوا من مكّة على كلّ صعب وذلول، فالعير أحبّ إليكم أم النفير؟
__________________
(١) أي: أسرعوا أسرعوا.
(٢) أي: رمى بها إلى فوق.
(٣) أي: المغنّيات، والواحدة: قينة.
(٤) في الصحاح (٣: ١٠٩١ ـ ١٠٩٢): «أعضضته الشيء فعضّه. ويقال: أعضضته سيفي، أي: ضربته به».
قالوا: بل العير أحبّ إلينا من لقاء العدوّ.
فتغيّر وجه رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثمّ ردّد عليهم فقال: إنّ العير قد مضت على ساحل البحر، وهذا أبو جهل قد أقبل.
فقالوا: يا رسول الله عليك بالعير ودع العدوّ.
فقام عند غضب النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم أبو بكر وعمر وقالا فأحسنا.
ثمّ قام سعد بن عبادة فقال: أنظر أمرك فامض، فو الله لو سرت إلى عدن أبين(١) ما تخلّف عنك رجل من الأنصار.
ثمّ قال المقداد بن عمرو: يا رسول الله إمض لـما أمرك الله، فإنّا معك حيث ما أحببت، لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى:( فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلا إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ ) (٢) ، ولكن إذهب أنت وربّك فقاتلا إنّا معكما مقاتلون، ما دامت عين منّا تطرف. فضحك رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم .
ثمّ قال: أشيروا عليّ أيّها الناس وهو يريد الأنصار، لأنّهم كانوا عدده، وقد قالوا له حين بايعوه على العقبة: إنّا برآء من ذمامك حتّى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمامنا، نمنعك ممّا نمنع منه أبناءنا ونساءنا.
فكان النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم يتخوّف أنّ الأنصار لا يروا نصرته إلّا على عدوّ دهمه بالمدينة.
فقام سعد بن معاذ فقال: لكأنّك تريدنا يا رسول الله؟
قال: أجل.
قال: قد آمنّا بك وصدّقناك، وشهدنا أنّ ما جئت به هو الحقّ، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لـما
__________________
(١) في الصحاح (٥: ٢٠٨٢): «أبين اسم رجل نسب إليه عدن، يقال: عدن أبين».
(٢) المائدة: ٢٤.
أردت، فو الّذي بعثك بالحقّ لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلّف منّا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوّنا، وإنّا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء، ولعلّ الله يريك منّا ما تقرّ به عينك، فسر بنا على بركة الله.
ففرح رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ، ونشّطه قول سعد ثم قال: سيروا على بركة الله وأبشروا، فإنّ الله وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأنّي الآن أنظر إلى مصارع القوم.
وروي أنّه قيل لرسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم حين فرغ من بدر: عليك بالعير ليس دونها شيء. فناداه العبّاس وهو في وثاقه: لا يصلح. فقال له النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم : لم؟ قال: لأنّ الله وعدك إحدى الطائفتين، وقد أعطاك ما وعدك.
وكانت تلك الكراهة من بعضهم لقوله:( وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ ) وهو في موقع الحال، أي: أخرجك في حال كراهتهم خروجك من بيتك إلى حرب مشركي مكّة في بدر.
( يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِ ) ينازعونك في إيثارك الجهاد بإظهار الحقّ، لإيثارهم تلقّي العير عليه.( بَعْدَ ما تَبَيَّنَ ) لهم أنّهم ينصرون أينما توجّهوا، وذلك بإعلام الرسول. وجدالهم قولهم: ما كان خروجنا إلّا للعير، وهلّا قلت لنا لنستعدّ ونتأهّب؟ وذلك لكراهتهم القتال.
ثمّ شبّه حالهم في فرط فزعهم ورعبهم وهم يسار بهم إلى الظفر والغنيمة، بحال من يجذب إلى القتل ويساق على الصغار إلى الموت المتيقّن، فقال:( كَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ) أي: يكرهون القتال كراهة من يساق إلى الموت وهو يشاهد أسبابه. وكان ذلك لقلّة عددهم، وعدم تأهّبهم، إذ روي أنّهم كانوا رجّالة، وما كان فيهم إلّا فارسان. وفيه إيماء إلى أنّ مجادلتهم إنما كانت لفرط فزعهم ورعبهم.
( وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّها لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَيَقْطَعَ دابِرَ الْكافِرِينَ (٧) لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْباطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (٨) إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ (٩) وَما جَعَلَهُ اللهُ إِلاَّ بُشْرى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (١٠) إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ وَلِيَرْبِطَ عَلى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ (١١) إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنانٍ (١٢) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (١٣) ذلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكافِرِينَ عَذابَ النَّارِ (١٤) )
( وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ ) إمّا النفير أو العير. وهذا على إضمار «اذكر». و «إحدى» ثاني مفعولي «يعدكم»، وقد أبدل منها قوله:( أَنَّها لَكُمْ ) بدل الاشتمال( وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ) يعني: العير، فإنّه لم يكن فيها إلّا أربعون فارسا، ولذلك يتمنّونها، ويكرهون الطائفة الّتي هي ذات الشوكة، لكثرة
عددهم وعدّتهم. والشوكة الحدّة، مستعارة من واحدة الشوك.
( وَيُرِيدُ اللهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَ ) أن يثبته، أي: يعزّ الإسلام ويعليه( بِكَلِماتِهِ ) بآياته المنزلة في محاربتهم، أو بأوامره للملائكة بالإمداد( وَيَقْطَعَ دابِرَ الْكافِرِينَ ) باستئصالهم وقتلهم وأسرهم وطرحهم في قليب بدر. والدابر: الآخر، من: دبر إذا أدبر. وقطع الدابر عبارة عن الاستئصال.
والمعنى: أنّكم تريدون الفائدة العاجلة، ولا تريدون مكروها، والله يريد ما يرجع إلى علوّ أمور الدين وإظهار الحقّ، وما يحصل لكم من فوز الدارين، فشتّان ما بين المرادين، ولذلك اختار لكم الطائفة ذات الشوكة، وكسر قوّتهم، وغلّبكم عليهم مع كثرتهم وقلّتكم، فأذلّهم وأعزّكم.
( لِيُحِقَّ الْحَقَ ) متعلّق بمحذوف، تقديره: فعل ذلك لتثبيت دين الحقّ( وَيُبْطِلَ الْباطِلَ ) أي: الشرك. وليس بتكرير، لأنّ الأوّل لبيان المراد، وما بينه وبين مرادهم من التفاوت، والثاني لبيان الداعي إلى حمل الرسولصلىاللهعليهوآلهوسلم على اختيار ذات الشوكة ونصرتهم عليها( وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ) ذلك.
روي عن أبي جعفرعليهالسلام قال: «إنّ النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم لـمّا نظر إلى المشركين وهم ألف، وإلى أصحابه وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر، فاستقبل القبلة ومدّ يده وقال: أللَّهمّ أنجز لي ما وعدتني، أللَّهمّ إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، فما زال يهتف كذلك حتّى سقط رداؤه من منكبيه، فأنزل الله تعالى:( إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ ) وهذا بدل من «إذ يعدكم»، أو متعلّق بقوله: «ليحقّ الحقّ»، أو على إضمار «اذكر».
وقيل: استغاثتهم أنّهم لـمّا علموا أن لا محيص عن القتال أخذوا يقولون: أي ربّ انصرنا على عدوّك، أغثنا يا غياث المستغيثين.
( فَاسْتَجابَ لَكُمْ ) فأغاثكم وأجاب دعوتكم( أَنِّي مُمِدُّكُمْ ) بأنّي ممدّكم، فحذف الجارّ وسلّط عليه الفعل.
وقرأ أبو عمرو بالكسر(١) على إرادة القول، أو إجراء «استجاب» مجرى
__________________
(١) أي: بكسر: إنّ.
«قال»، لأنّ الاستجابة من القول.
( بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ ) عليهم ثياب بيض وعمائم بيض، قد أرخوا أذنابها بين أكتافهم( مُرْدِفِينَ ) متبعين المؤمنين، أو متبعين بعضهم بعضا، من: أردفته إذا جئت بعده، أو متبعين بعضهم بعض المؤمنين أو أنفسهم المؤمنين، من: أردفته إيّاه فردفه.
وقرأ نافع ويعقوب: مردفين بفتح الدال، أي: متبعين أو متّبعين، بمعنى: أنّهم كانوا مقدّمة الجيش أو ساقتهم.
( وَما جَعَلَهُ اللهُ ) أي: إمدادكم بالملائكة( إِلَّا بُشْرى ) إلّا بشارة لكم بالنصر( وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ) فيزول ما بها من الوجل، لقلّتكم وذلّتكم( وَمَا النَّصْرُ ) بالملائكة وغيرهم من الأسباب( إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ ) فينصر من يشاء، قلّ العدد أم كثر( إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ ) لا يمنع عن مراده( حَكِيمٌ ) في أفعاله، يجريها على ما تقتضيه الحكمة. وإمداد الملائكة وكثرة العدد والأهب ونحوهما وسائط، فلا تحسبوا النصر منها حقيقة، ولا تيأسوا منه بفقدها.
واختلف في أنّ الملائكة هل قاتلت يوم بدر أم لا؟ فقيل: ما قاتلت ولكن شجّعت وكثّرت سواد المسلمين وبشّرت بالنصر، وإلّا فملك واحد كاف في إهلاك أهل الدنيا كلّهم، فإنّ جبرئيل أهلك بريشة من جناحه مدائن قوم لوط، وأهلك بلاد ثمود وقوم صالح بصيحة واحدة.
وقيل: إنّها قاتلت. وروي عن ابن مسعود أنّه سأله أبو جهل من أين يأتينا الضرب ولا نرى الشخص؟ فقال: من قبل الملائكة. فقال: هم غلبونا لا أنتم.
وعن ابن عبّاس أيضا: أنّ الملائكة قاتلت يوم بدر. وفي رواية: قاتلت يوم بدر، ولم تقاتل يوم الأحزاب ويوم حنين.
وروي: أنّ رجلا من المسلمين بينما هو يشتدّ في أثر رجل من المشركين إذ سمع صوت ضربة بالسوط فوقه، فنظر إلى المشرك قد خرّ مستلقيا وشقّ وجهه، فحدّث الأنصاري رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فقال: صدقت ذلك من مدد السّماء.
وعن أبي داود المازني: تبعت رجلا من المشركين لأضربه يوم بدر، فوقع رأسه بين يدي قبل أن يصل إليه سيفي.
وقوله:( إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ ) بدل ثان من «إذ يعدكم»، أو متعلّق بالنصر، أو بما في «عند الله» من معنى الفعل، أو يجعل «أو» بإضمار «اذكر».
وقرأ نافع بالتخفيف، من: أغشيته الشيء إذا غشّيته إيّاه. والفاعل على القراءتين هو الله تعالى. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: يغشاكم النّعاس بالرفع.
( أَمَنَةً مِنْهُ ) أمنا من الله تعالى. وهو مفعول له باعتبار المعنى، فإنّ قوله( يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ ) متضمّن معنى: تنعسون، و «يغشاكم» بمعناه، فيكون فاعل الفعل المعلّل والعلّة واحدا. و «منه» صفة لـ «أمنة». والمعنى: إذ يتغشّون لأمنكم الحاصل من الله بإزالة الرعب من قلوبكم، فإنّ الإنسان لا يأخذه النوم في حال الخوف، فآمنهم الله تعالى بزوال الرعب عن قلوبهم، كما يقال: الخوف مسهر، والأمن منيم. والأمنة الدعة الّتي تنافي المخافة.
وعن ابن عبّاس: النعاس في القتال أمنة من الله، وفي الصّلاة وسوسة الشيطان.
( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ) من الحدث والجنابة( وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ ) يعني: الجنابة، لأنّه من تخييله أو وسوسته وتخويفه إيّاهم من العطش، وذلك أنّ المشركين قد سبقوهم إلى الماء، ونزل المسلمون في كثيب(١) أعفر تسوخ فيه الأقدام، وناموا فاحتلم أكثرهم، فتمثّل لهم إبليس وقال: يا أصحاب محمد أنتم تزعمون أنّكم على الحقّ، وأنتم تصلّون على الجنابة، وقد عطشتم، ولو كنتم على حقّ ما غلبكم هؤلاء على الماء، وها هم الآن يمشون إليكم، فيقتلونكم ويسوقون بقيّتكم إلى مكّة. فحزنوا لذلك، فأنزل الله المطر، فمطروا ليلا حتّى جرى
__________________
(١) الكثيب: التلّ من الرمل.
الوادي، واغتسلوا وتوضّؤوا، واتّخذوا الحياض على عدوة(١) الوادي، وتلبّد(٢) الرمل الّذي كان بينهم وبين العدوّ حتّى ثبتت عليه الأقدام، وزالت وسوسة الشيطان، وطابت النفوس.
( وَلِيَرْبِطَ عَلى قُلُوبِكُمْ ) وليشدّ عليها. ومعناه: يشجّع قلوبكم، ويزيدكم قوّة قلب وسكون نفس، والثقة على لطف الله( وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ ) أي: بالمطر حتّى لا تسوخ في الرمل، أو بالربط على القلوب حتّى تثبت في المعركة، فإنّ الجرأة تثبّت القدم في مواطن الحرب.
( إِذْ يُوحِي رَبُّكَ ) بدل ثالث، أو متعلّق بـ «يثبّت»( إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ ) في إعانتهم وتثبيتهم. وهو مفعول «يوحي».( فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ) بالبشارة، أو بتكثير سوادهم، أو بمجاهدة أعدائهم.
وقوله:( سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ) كالتفسير لقوله:( أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا ) . ولا معونة أعظم من إلقاء الرعب في قلوب الكفّار، ولا تثبيت أبلغ من ضرب أعناقهم.( فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ ) أي: أعاليها الّتي هي المذابح، لأنّها مفاصل، فكان إيقاع الضرب فيها حزّا وتطييرا للرؤوس، لأنّها فوق الأعناق( وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنانٍ ) أصابع، أي: حزّوا رقابهم واقطعوا أطرافهم من اليدين والرجلين، فإنّ الضرب إمّا واقع على مقتل أو غير مقتل، فأمرهم بأن يجمعوا عليهم النوعين معا.
وفيه دليل على أنّهم قاتلوا. ومن منع ذلك جعل الخطاب فيه مع المؤمنين، إمّا على تغيير الخطاب، أو على أنّ قوله: «سألقي» إلى قوله: «كلّ بنان» تلقين للملائكة ما يثبّتون المؤمنين به، كأنّه قال: قولوا لهم قولي هذا.
( ذلِكَ ) إشارة إلى ما وقع بهم من القتل أو الأمر به. والخطاب في «ذلك»
__________________
(١) العدوة: المكان المتباعد، أو المرتفع.
(٢) تلبّد الرمل أي: تجمّع ولصق بعضه ببعض.
للرسول، أو لكلّ أحد من المخاطبين قبل( بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ وَرَسُولَهُ ) أي: ذلك العقاب العاجل أو أمر الملائكة به بسبب مشاقّتهم ومخالفتهم لهما. واشتقاقه من الشقّ، لأنّ كلّا من المعاندين في شقّ خلاف شقّ الآخر، كالمعاداة من العدوة بمعنى الجانب، والمخاصمة من الخصم، وهو أيضا الجانب.
وقوله:( وَمَنْ يُشاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ ) تقرير للتعليل، أو وعيد بما أعدّ لهم في الآخرة بعد ما حاق بهم في الدنيا.
( ذلِكُمْ ) الخطاب فيه مع الكفرة على طريقة الالتفات. ومحلّه الرفع، أي: الأمر ذلكم، أو ذلكم واقع، أو نصب بفعل دلّ عليه قوله:( فَذُوقُوهُ ) أو غيره، مثل: باشروا أو عليكم، فتكون الفاء عاطفة( وَأَنَّ لِلْكافِرِينَ عَذابَ النَّارِ ) عطف على «ذلكم»، أو نصب على المفعول معه. والمعنى: ذوقوا ما عجّل لكم مع ما أجّل لكم في الآخرة. ووضع الظاهر فيه موضع الضمير للدلالة على أنّ الكفر سبب العذاب الآجل، أو الجمع بينهما.
( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ (١٥) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (١٦) فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللهَ رَمى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٧) ذلِكُمْ وَأَنَّ اللهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكافِرِينَ (١٨) )
ولـمّا أمدّ سبحانه المسلمين بالملائكة، ووعدهم النصر والظفر بالكفّار، نهاهم عقيبه عن الفرار، فقال:( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً )
متزاحفين. حال من( الَّذِينَ كَفَرُوا ) . والزحف: الجيش الدهم(١) الّذي يرى لكثرته كأنّه يزحف، أي: يدبّ دبيبا، من: زحف الصبيّ إذا دبّ على استه قليلا قليلا، سمّي بالمصدر. والجمع زحوف. والمعنى: إذا لقيتموهم للقتال وهم كثير جمّ وأنتم قليل.( فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ ) فلا تنصرفوا عنهم منهزمين من العدوّ.
ويجوز أن يكون حالا من الفاعل والمفعول، أي: إذا لقيتموهم متزاحفين يدبّون إليكم وتدبّون إليهم فلا تنهزموا. أو حال من الفاعل، كأنّهم أخبروا بما سيكون منهم يوم حنين حين تولّوا مدبرين وهم زحف اثنا عشر ألفا.
( وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ ) يريد الكرّ بعد الفرّ، يخيّل عدوّه أنّه منهزم ثمّ يعطف عليه، وهو باب من خدع الحرب ومكايدها. أو يكون التحرّف لأجل إصلاح لأمته(٢) وسائر أسلحته( أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ ) أو منحازا إلى فئة اخرى من المسلمين على القرب ليستعين بهم. وانتصابهما على الحال، و «إلّا» لغو لا عمل لها. أو على الاستثناء من المولّين، أي: ومن يولّهم إلّا رجلا منهم متحرّفا أو متحيّزا. ووزن متحيّز متفيعل لا متفعّل، لأنّه من: حاز يحوز، فبناء متفعّل منه متحوّز.
( فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ) هذا إذا لم يزد العدوّ على الضعف، لقوله:( الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ ) (٣) الآية.
وقيل: الآية مخصوصة بأهل بيته والحاضرين معه في الحرب.
وعن ابن عبّاس: أنّ الفرار من الزحف من أكبر الكبائر.
روي أنّه لـمّا طلعت قريش من العقنقل قالصلىاللهعليهوآلهوسلم داعيا لله تعالى: هذه قريش
__________________
(١) الدّهم: العدد الكثير.
(٢) اللأمة: الدرع.
(٣) الأنفال: ٦٦.