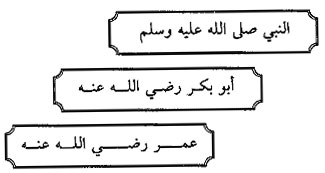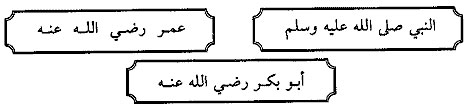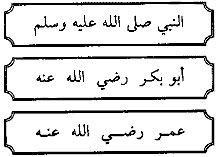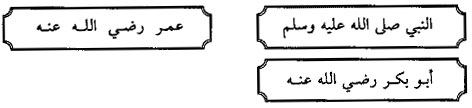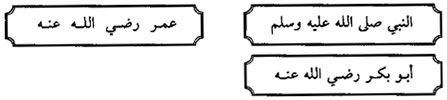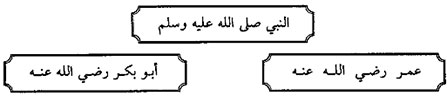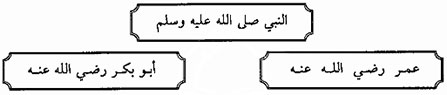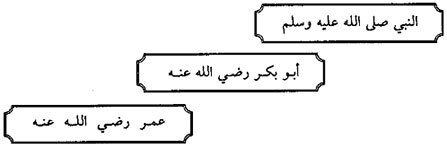وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى الجزء ٢
 0%
0%
 مؤلف: نور الدين علي بن أحمد السّمهودي
مؤلف: نور الدين علي بن أحمد السّمهودي
المحقق: خالد عبد الغني محفوظ
الناشر: دار الكتب العلميّة
تصنيف: مكتبة الحديث وعلومه
الصفحات: 282

مؤلف: نور الدين علي بن أحمد السّمهودي
المحقق: خالد عبد الغني محفوظ
الناشر: دار الكتب العلميّة
تصنيف:
المشاهدات: 102122
تحميل: 7093
توضيحات:
- الفصل الرابع : الروايات في حنين الجذع
- صانع المنبر
- موضع الجذع
- شهرة حديث حنين الجذع
- الموضع الذي دفن فيه الجذع
- بدعة اصطنعها الناس بسبب الجذع
- عود إلى الاختلاف في صانع المنبر
- أراد معاوية أن ينقل المنبر إلى الشام
- رفع المنبر ست درجات
- عدد درجات المنبر
- مساحة المنبر
- كسوة المنبر
- ستور الأبواب كسوة الحجارة
- الفصل الخامس
- في فضائل المسجد الشريف
- المسجد الذي أسس على التقوى
- فضل مسجد رسول الله صلىاللهعليهوسلم
- هل فضل الصلاة في المساجد الثلاثة يختص بالفرض؟
- مرجع مضاعفة فضل الصلاة
- هل يختص التضعيف بالصلاة؟
- الفصل السادس في فضل المنبر المنيف ، والروضة الشريفة
- معنى كون المنبر على الحوض
- معنى أن الروضة من رياض الجنة
- الفصل السابع
- في الأساطين المنيفة
- الأسطوان المخلق
- أسطوان القرعة
- أسطوان التوبة
- أسطوان السرير
- أسطوان المحرس
- أسطوان الوفود
- أسطوان مربعة القبر
- أسطوان التهجد
- الفصل الثامن
- في الصّفة وأهلها ، وتعليق الأقناء لهم بالمسجد
- وصف الصفة وموضعها
- أهل الصفة
- مبدأ تعليق الأقناء
- الفصل التاسع
- في الحجرة الشريفة ، وبيان إحاطتها بالمسجد الشريف إلا من جهة المغرب
- المشربة
- الفصل العاشر
- في حجرة فاطمة بنت النبي صلىاللهعليهوسلم و رضياللهعنها
- الفصل الحادي عشر
- في الأمر بسدّ الأبواب الشارعة في المسجد الشريف
- الفصل الثاني عشر
- في زيادة عمر بن الخطاب رضياللهعنه في المسجد
- بين عمر والعباس
- الفصل الثالث عشر
- في البطيحاء التي بناها عمر رضياللهعنه بناحية المسجد ، ومنعه من
- إنشاد الشعر ورفع الصوت فيه ، وما جاء في ذلك
- الفصل الرابع عشر
- في زيادة عثمان بن عفان رضياللهعنه
- الفصل الخامس عشر
- في المقصورة التي اتخذها عثمان رضياللهعنه في المسجد
- وما كان من أمرها بعده
- الفصل السادس عشر
- في زيادة الوليد بن عبد الملك على يد عمر بن عبد العزيز
- الفصل السابع عشر
- فيما اتخذه عمر في المسجد في زيادة الوليد من المحراب والشّرفات والمنائر ،
- واتخاذ الحرس ، ومنعهم من الصلاة على الجنائز فيه
- أول من أحدث المحراب والشرفات
- عثمان أول من خلق المسجد ورزق المؤذنين
- اتخاذ حرس للمسجد
- الصلاة على الجنائز في المساجد
- الشيعة غير الأشراف
- الفصل الثامن عشر
- في زيادة المهدي
- الفصل التاسع عشر
- فيما كانت عليه الحجرة الشريفة الحاوية للقبور المنيفة في مبدأ الأمر
- أول من بنى جدارا على بيت عائشة
- الفصل العشرون
- فيما حدث من عمارة الحجرة بعد ذلك ، والحائز الذي أدير عليها
- الفصل الحادي والعشرون
- فيما روي من الاختلاف في صفة القبور الشريفة ، بالحجرة المنيفة
- رواية نافع في وضع القبور
- رواية القاسم بن محمد
- رواية عثمان بن نسطاس
- رواية المنكدر بن محمد
- رواية عمرة عن عائشة
- رواية أخرى عن القاسم بن محمد
- رواية عبد الله بن محمد بن عقيل
- بقي بعدها موضع قبر
- الملائكة يحفون بالقبر
- لا ينبغي رفع الصوت في المسجد
- سنة أهل المدينة في أعوام الجدب
- الفصل الثاني والعشرون
- ما شاهدناه مما يخالف ذلك
- الفصل الثالث والعشرون
- في عمارة اتفقت بالحجرة الشريفة على ما نقله الأقشهري عن ابن عاث ، وما
- وقع من الدخول إليها عند الحاجة له وتأزيرها بالرخام
- الفصل الرابع والعشرون
- كسوة الحجرة النبوية
- الفصل الخامس والعشرون
- في قناديل الذهب والفضة التي تعلق حول الحجرة الشريفة ،
- وغيرها من معاليقها
- القناديل
- حكم معاليق المسجد النبوي
- الفصل السادس والعشرون
- في الحريق الأول القديم المستولي على تلك الزخارف المحدثة بالحجرة
- الشريفة والمسجد وسقفهما ، وما أعيد من ذلك ، وما تجدد من توسعة المسقف
- القبلي بزيادة الرواقين فيه ، وغير ذلك
- سبب الحريق وتاريخه
- حكمة الله في الحريق
- الشروع في العمارة بعد الحريق
- الفصل السابع والعشرون
- في اتخاذ القبة الزرقاء التي جعلت على ما يحاذي سقف الحجرة الشريفة
- القبة الزرقاء
- المقصورة الدائرة على الحجرة
- الفصل الثامن والعشرون
- فيما تجدد من عمارة الحجرة الشريفة في زماننا على وجه لم يخطر قط
- بأذهاننا ، وما حصل بسببه من إزالة هدم الحريق الأول من ذلك المحل
- الشريف ، ومشاهدة وضعه المنيف ، وتصوير ما استقر عليه أمر الحجرة في
- هذه العمارة
- الفصل التاسع والعشرون
- في الحريق الحادث في زماننا بعد العمارة السابقة وما ترتب عليه
- خاتمة
- فيما نقل من عمل نور الدين الشهيد لخندق حول الحجرة الشريفة مملوء
- بالرصاص ، وذكر السبب في ذلك ، وما ناسبه
- الفصل الثلاثون
- في تحصيب المسجد الشريف
- وذكر البزاق فيه ، وتخليقه ، وإجماره ، وذكر شيء من أحكامه
- أول تحصيب المسجد النبوي
- حكم البزاق في المسجد
- مبدأ تخليق المسجد
- تخليق القبر
- تجمير المساجد
- فرش المساجد
- الحدث في المسجد
- القراءة في المصحف بالمسجد
- بعث المصاحف إلى المساجد
- مصاحف عثمان التي أرسلها إلى الآفاق
- تعليق المصابيح في المسجد وصف عام
- الفصل الحادي والثلاثون
- فيما احتوى عليه المسجد من الأروقة والأساطي
- ن والبالوعات والسقايات والدروع ، وغير ذلك مما يتعلق به من الرسوم
- وصف عام
- جدران المسجد
- عدد أساطين المسجد
- عدد بالوعات المسجد
- سقايات المسجد
- حواصل المسجد
- قناديل المسجد
- في صحن المسجد نخيل مغروسة
- أئمة المسجد
- عرض جدار المسجد
- الفصل الثاني والثلاثون
- في أبواب المسجد وما سد منها ، وما بقي ،
- وما يحاذيها من الدور قديما وحديثا
- أبواب المسجد
- باب النبي صلىاللهعليهوسلم
- باب علي
- باب عثمان باب جبريل
- باب ريطة (باب النساء)
- باب سادس
- باب سابع
- باب ثامن
- أبواب المسجد الشامية
- باب تاسع
- باب عاشر
- الباب الحادي عشر
- الباب الثاني عشر
- الباب الثالث عشر
- الباب الرابع عشر
- الباب الخامس عشر
- الباب السادس عشر
- باب عاتكة (باب السوق) (وباب الرحمة)
- باب زياد (باب القضاء)
- خوخة تجاه خوخة أبي بكر
- الفصل الثالث والثلاثون
- في خوخة آل عمر رضي الله تعالى عنه المتقدم ذكرها ،
- وما يتعين من سدّها في زماننا
- تحديد موضع خوخة آل عمر
- اتخاذ بعض الناس بابا وسيلة للتدجيل
- حج السلطان قايتباي
- وقف السلطان قايتباي لأهل المدينة المنورة
- من آثار قايتباي بالحرمين الشريفين
- الفصل الرابع والثلاثون
- فيما كان مطيفا بالمسجد الشريف من الدور ، وما كان من خبرها ، وجلّ ذلك
- من منازل المهاجرين رضي الله تعالى عنهم
- رسول الله يخط دور المدينة
- دار آل عمر بن الخطاب
- بيت لأبي بكر الصديق صار لآل عمر
- دار مروان بن الحكم
- دار رباح ودار المقداد
- دار مطيع بن الأسود
- دار حكيم بن حزام
- دار عبد الله بن مكمل
- دار النحام
- دار جعفر بن يحيى
- دار نصير
- دار منيرة مولاة أم موسى
- حش طلحة
- أبيات خالصة
- دار حميد بن عبد الرحمن بن عوف
- دار موسى المخزومي
- أبيات الصوافي
- دار خالد بن الوليد
- دار أسماء بنت حسين
- دار ريطة
- دار عثمان بن عفان
- دار أبي أيوب الأنصاري
- دار جعفر الصادق
- دار حسن بن زيد
- دار فرج الخصي
- دار عامر بن الزبير بن العوام
- الفصل الخامس والثلاثون
- في البلاط ، وبيان ما ظهر لنا مما كان حوله من منازل المهاجرين
- تحديد مكان البلاط
- حدود البلاط
- بيان الدور المطيفة بالبلاط
- الفصل السادس والثلاثون
- فيما جاء في سوق المدينة التي تصدق به النبي صلىاللهعليهوسلم على المسلمين ، وذكر دار
- هشام بن عبد الملك التي أخذ بها السوق
- الرسول ينشئ السوق
- أسواق المدينة في الجاهلية
- هدم الدار التي وضعت مكان السوق
- بيت أم كلاب
- البطحاء
- بقيع الخيل
- بركة السوق
- الفصل السابع والثلاثون
- في منازل القبائل من المهاجرين ، ثم اتخاذ السور على المدينة
- منازل بني غفار
- منازل بني ليث بن بكر
- منازل بني ضمرة بن بكر
- منازل بني الديل
- منازل ابني أفصى
- منازل مزينة ومن حل معها
- منازل بني جشم
- منازل بني كعب بن عمرو ، وإخوتهم من بني المصطلق
- سعة المدينة في عهد النبي
- اتخاذ سور المدينة
- سور آل زنكي
- من مآثر الجواد الأصفهاني
- أبواب السور