مرآة العقول الجزء ٢٣
 0%
0%
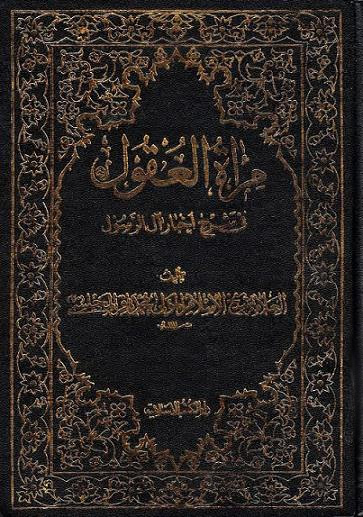 مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 446
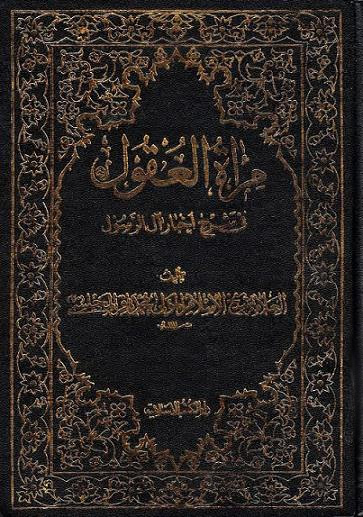
مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف:
المشاهدات: 47508
تحميل: 4357
توضيحات:
- كتاب الوصايا
- ( باب )
- ( الوصية وما أمر بها )
- كتاب الوصايا
- باب الوصية وما أمر بها
- ( باب )
- ( الإشهاد على الوصية )
- باب الإشهاد على الوصية
- ( باب )
- ( الرجل يوصي إلى آخر ولا يقبل وصيته )
- باب الرجل يوصي إلى آخر ولا يقبل وصيته
- ( باب )
- ( أن صاحب المال أحق بماله ما دام حيا )
- باب أن صاحب المال أحق بما له ما دام حيا
- ( باب )
- ( الوصية للوارث )
- باب الوصية للوارث
- ( باب )
- ( ما للإنسان أن يوصي به بعد موته وما يستحب له من ذلك )
- باب ما للإنسان أن يوصي به بعد موته وما يستحب له من ذلك
- ( باب )
- ( باب )
- ( الرجل يوصي بوصية ثم يرجع عنها )
- باب الرجل يوصي بوصية ثم يرجع عنها
- ( باب )
- ( من أوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصي )
- ( أو مات قبل أن يقبضها )
- باب من أوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصى أو مات قبل أن يقبضها
- ( باب )
- ( إنفاذ الوصية على جهتها )
- باب إنفاذ الوصية على جهتها
- ( باب آخر منه )
- ( باب آخر منه )
- باب آخر منه
- باب آخر منه
- ( باب )
- ( من أوصى بعتق أو صدقة أو حج )
- باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج
- ( باب )
- ( أن من حاف في الوصية فللوصي أن يردها إلى الحق )
- باب أن من خاف في الوصية فللوصي أن يردها إلى الحق
- ( باب )
- ( أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن )
- ( باب )
- ( أن المدبر من الثلث )
- باب أن المدبر من الثلث
- ( باب )
- ( أنه يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية )
- ( باب )
- ( من أوصى وعليه دين )
- باب من أوصى وعليه دين
- ( باب )
- ( من أعتق وعليه دين )
- باب من أعتق وعليه دين
- ( باب )
- ( الوصية للمكاتب )
- باب الوصية للمكاتب
- ( باب )
- ( وصية الغلام والجارية التي لم تدرك وما يجوز منها وما لا يجوز )
- باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك وما يجوز منها وما لا يجوز
- ( باب )
- ( الوصية لأمهات الأولاد )
- باب الوصية لأمهات الأولاد
- ( باب )
- ( ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى )
- ( والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره )
- باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمري والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره
- ( باب )
- ( من أوصى بجزء من ماله )
- باب من أوصى بجزء من ماله
- ( باب )
- ( من أوصى بشيء من ماله )
- باب من أوصى بشيء من ماله
- ( باب )
- ( من أوصى بسهم من ماله )
- باب من أوصى بسهم من ماله
- ( باب )
- ( المريض يقر لوارث بدين )
- باب المريض يقر لوارث بدين
- ( باب )
- ( بعض الورثة يقر بعتق أو دين )
- باب بعض الورثة يقر بعتق أو دين
- ( باب )
- ( الرجل يترك الشيء القليل وعليه دين أكثر منه وله عيال )
- باب الرجل يترك الشيء القليل وعليه دين أكثر منه وله عيال
- ( باب )
- ( باب )
- ( من لا تجوز وصيته من البالغين )
- ( باب )
- ( من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسم بينهم )
- باب من لا تجوز وصيته من البالغين
- باب من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسم بينهم
- ( باب )
- ( من أوصى إلى مدرك وأشرك معه الصغير )
- باب من أوصى إلى مدرك وأشرك معه الصغير
- ( باب )
- ( من أوصى إلى اثنين فينفرد كل واحد منهما ببعض التركة )
- باب من أوصى إلى اثنين فينفرد كل واحد منهما ببعض التركة
- ( باب )
- ( صدقات النبي صلىاللهعليهوآله وفاطمة والأئمة عليهمالسلام ووصاياهم )
- ( باب )
- ( ما يلحق الميت بعد موته )
- باب ما يلحق الميت بعد موته
- ( باب النوادر )
- باب النوادر
- ( باب )
- ( من مات على غير وصية وله وارث صغير فيباع عليه )
- باب من مات على غير وصية وله وارث صغير فيباع عليه
- ( باب )
- ( الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم ومن يدرك )
- ( ولا يؤنس منه الرشد وحد البلوغ )
- باب الموصى يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم ومن يدرك ولا يونس منه الرشد وحد البلوغ
- كتاب المواريث
- ( باب )
- ( وجوه الفرائض )
- كتاب المواريث
- باب وجوه الفرائض
- ( باب )
- ( بيان الفرائض في الكتاب )
- ( باب )
- ( باب )
- ( أن الميراث لمن سبق إلى سهم قريبه وأن ذا السهم أحق ممن لا سهم له )
- ( باب )
- ( أن الفرائض لا تقام إلا بالسيف )
- باب أن الميراث لمن سبق إلى سهم قريبه وأن ذا السهم أحق ممن لا سهم له
- ( باب نادر )
- باب نادر
- ( باب )
- ( في إبطال العول )
- باب في إبطال العول
- ( باب )
- ( آخر في إبطال العول وأن السهام لا تزيد على ستة )
- باب آخر في إبطال العول وأن السهام لا تزيد على ستة
- ( باب )
- ( معرفة إلقاء العول )
- باب معرفة إلقاء العول
- ( باب )
- ( أنه لا يرث مع الولد والوالدين إلا زوج أو زوجة )
- باب أنه لا يرث مع الولد والوالدين إلا زوج أو زوجة
- ( باب )
- ( العلة في أن السهام لا تكون أكثر من ستة وهو من كلام يونس )
- باب العلة في أن السهام لا تكون أكثر من ستة وهو من كلام يونس
- ( باب )
- ( علة كيف صار للذكر سهمان وللأنثى سهم )
- باب علة كيف صار للذكر سهمان وللأنثى سهم
- (باب)
- (ما يرث الكبير من الولد دون غيره)
- باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره
- ( باب )
- ( ميراث الولد )
- باب ميراث الولد
- ( باب )
- ( ميراث ولد الولد )
- باب ميراث ولد الولد
- ( باب )
- ( ميراث الأبوين )
- باب ميراث الأبوين
- ( باب )
- ( ميراث الأبوين مع الإخوة والأخوات لأب والإخوة )
- ( والأخوات لأم )
- باب
- ميراث الأبوين مع الأخوة والأخوات لأب والأخوة والأخوات لأم
- ( باب )
- ( ميراث الولد مع الأبوين )
- باب ميراث الولد مع الأبوين
- ( باب )
- ( ميراث الولد مع الزوج والمرأة والأبوين )
- باب ميراث الولد مع الزوج والمرأة والأبوين
- ( باب )
- ( ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة )
- باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة
- ( باب الكلالة )
- باب الكلالة
- ( باب )
- ( ميراث الإخوة والأخوات مع الولد )
- باب ميراث الأخوة والأخوات مع الولد
- ( باب الجد )
- ( باب )
- ( الإخوة من الأم مع الجد )
- باب الأخوة من الأم مع الجد
- ( باب )
- ( ابن أخ وجد )
- باب ابن أخ وجد
- ( باب )
- ( ميراث ذوي الأرحام )
- باب ميراث ذوي الأرحام
- ( باب )
- ( المرأة تموت ولا تترك إلا زوجها )
- باب المرأة تموت ولا تترك إلا زوجها
- ( باب )
- ( الرجل يموت ولا يترك إلا امرأته )
- باب الرجل يموت ولا يترك إلا امرأته
- ( باب )
- ( أن النساء لا يرثن من العقار شيئا )
- باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا
- ( باب )
- ( اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت )
- باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت
- ( باب نادر )
- ( باب )
- ( ميراث الغلام والجارية يزوجان وهما غير مدركين )
- باب ميراث الغلام والجارية يزوجان وهما غير مدركين
- ( باب )
- ( ميراث المتزوجة المدركة ولم يدخل بها )
- باب ميراث المتزوجة المدركة ولم يدخل بها
- ( باب )
- ( في ميراث المطلقات في المرض وغير المرض )
- باب ميراث المطلقات في المرض وغير المرض
- ( باب )
- ( ميراث ذوي الأرحام مع الموالي )
- باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي
- ( باب )
- ( ميراث الغرقى وأصحاب الهدم )
- باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم
- ( باب )
- ( مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث )
- باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث
- ( باب )
- ( ميراث القاتل )
- باب ميراث القاتل
- ( باب )
- ( ميراث أهل الملل )
- باب ميراث أهل الملل
- ( باب )
- ( آخر في ميراث أهل الملل )
- باب آخر في ميراث أهل الملل
- ( باب )
- ( أن ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله وسنة )
- ( نبيه صلىاللهعليهوآله )
- ( باب )
- ( من يترك من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون )
- ( باب )
- ( ميراث المماليك )
- باب من يترك من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون
- باب ميراث المماليك
- ( باب )
- ( أنه لا يتوارث الحر والعبد )
- باب أنه لا يتوارث الحر والعبد
- ( باب )
- ( الرجل يترك وارثين أحدهما حر والآخر مملوك )
- باب الرجل يترك وارثين أحدهما حر والآخر مملوك
- ( باب )
- ( باب )
- ( ميراث المكاتبين )
- باب ميراث المكاتبين
- ( باب )
- ( ميراث المرتد عن الإسلام )
- باب ميراث المرتد عن الإسلام
- ( باب )
- ( ميراث المفقود )
- باب ميراث المفقود
- ( باب )
- ( ميراث المستهل )
- باب ميراث المستهل
- ( باب )
- ( ميراث الخنثى )
- باب ميراث الخنثى
- ( باب )
- ( آخر منه )
- باب آخر منه
- ( باب )
- باب الحديث
- ( باب آخر منه )
- باب آخر [ منه ]
- ( باب )
- ( ميراث ابن الملاعنة )
- باب ميراث ابن الملاعنة
- ( باب )
- ( آخر في ابن الملاعنة )
- باب آخر في ابن الملاعنة
- ( باب )
- ( ميراث ولد الزنى )
- باب ميراث ولد الزنا
- ( باب )
- ( آخر منه )
- باب آخر منه
- ( باب )
- ( باب الحميل )
- باب الحميل
- ( باب )
- ( الإقرار بوارث آخر )
- باب الإقرار بوارث آخر
- ( باب )
- ( إقرار بعض الورثة بدين )
- باب إقرار بعض الورثة بدين على الميت
- ( باب )
- ( باب )
- ( من مات وليس له وارث )
- باب من مات وليس له وارث
- ( باب )
- ( باب )
- ( أن الولاء لمن أعتق )
- باب أن الولاء لمن أعتق
- ( باب )
- ( ولاء السائبة )
- باب ولاء السائبة
- ( باب )
- ( آخر منه )
- باب آخر منه
- كتاب الحدود
- ( باب التحديد )
- كتاب الحدود
- باب التحديد
- ( باب )
- ( الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك )
- باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك
- ( باب )
- ( ما يحصن وما لا يحصن وما [ لا ] يوجب الرجم على المحصن )
- باب ما يحصن وما لا يحصن وما لا يوجب الرجم على المحصن
- ( باب )
- ( الصبي يزني بالمرأة المدركة والرجل يزني بالصبية )
- ( غير المدركة )
- باب الصبي يزني بالمرأة المدركة والرجل يزني بالصبية
- ( باب )
- ( ما يوجب الجلد )
- باب ما يوجب الجلد
- ( باب )
- ( صفة حد الزاني )
- باب صفة حد الزاني
- ( باب )
- ( ما يوجب الرجم )
- باب ما يوجب الرجم
- ( باب )
- ( صفة الرجم )
- باب صفة الرجم
- ( باب )
- ( آخر منه )
- باب آخر منه
- ( باب )
- ( الرجل يغتصب المرأة فرجها )
- باب الرجل يغتصب المرأة فرجها
- ( باب )
- ( من زنى بذات محرم )
- باب من زنى بذات محرم
- ( باب )
- ( في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة )
- باب في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة
- (باب)
- (المجنون والمجنونة يزنيان)
- باب المجنون والمجنونة يزنيان
- ( باب )
- ( حد المرأة التي لها زوج فتزوج أو تتزوج وهي في عدتها )
- ( والرجل الذي يتزوج ذات زوج )
- باب حد المرأة التي لها زوج فتزوج أو تتزوج وهي في عدتها والرجل الذي يتزوج ذات زوج
- ( باب )
- ( الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك والرجل يأتي مكاتبته )
- باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك والرجل يأتي مكاتبته
- ( باب )
- ( المرأة المستكرهة )
- ( باب )
- ( الرجل يزني في اليوم مرارا كثيرة )
- باب المرأة المستكرهة
- باب الرجل يزني في يوم مرارا كثيرة
- ( باب )
- ( الرجل يزوج أمته ثم يقع عليها )
- ( باب )
- ( نفي الزاني )
- باب الرجل يزوج أمته ثم يقع عليها
- باب نفي الزاني
- ( باب )
- ( حد الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما )
- ( باب )
- ( الحد في اللواط )
- باب الحد في اللواط
- ( باب )
- ( آخر منه )
- باب آخر منه
- ( باب )
- ( الحد في السحق )
- باب الحد في السحق
- ( باب )
- ( آخر منه )
- باب آخر منه
- ( باب )
- ( الحد على من يأتي البهيمة )
- باب الحد على من يأتي البهيمة
- ( باب )
- ( حد القاذف )
- باب حد القاذف
- ( باب )
- ( الرجل يقذف جماعة )
- باب الرجل يقذف جماعة
- ( باب في نحوه )
- باب في نحوه
- ( باب )
- ( الرجل يقذف امرأته وولده )
- باب الرجل يقذف امرأته وولده
- ( باب )
- ( صفة حد القاذف )
- باب صفة حد القاذف
- ( باب )
- ( ما يجب فيه الحد في الشراب )
- باب ما يجب فيه الحد في الشراب
- ( باب )
- ( الأوقات التي يحد فيها من وجب عليه الحد )
- باب الأوقات التي يحد فيها من وجب عليه الحد
- ( باب )
- ( أن شارب الخمر يقتل في الثالثة )
- باب أن شارب الخمر يقتل في الثالثة
- ( باب )
- ( ما يجب على من أقر على نفسه بحد ومن لا يجب عليه الحد )
- ( باب )
- ( قيمة ما يقطع فيه السارق )
- باب قيمة ما يقطع فيه السارق
- ( باب )
- ( حد القطع وكيف هو )
- باب حد القطع وكيف هو
- ( باب )
- ( ما يجب على الطرار والمختلس من الحد )
- باب فيما يجب على الطرار والمختلس من الحد
- ( باب )
- ( الأجير والضيف )
- باب الأجير والضيف
- ( باب )
- ( حد النباش )
- باب حد النباش
- ( باب )
- ( حد من سرق حرا فباعه )
- باب حد من سرق حرا فباعه
- ( باب )
- ( نفي السارق )
- باب نفي السارق
- ( باب )
- ( ما لا يقطع فيه السارق )
- باب ما لا يقطع فيه السارق
- ( باب )
- ( أنه لا يقطع السارق في المجاعة )
- باب أنه لا يقطع السارق في المجاعة
- ( باب )
- ( حد الصبيان في السرقة )
- باب حد الصبيان في السرقة
- ( باب )
- ( ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد )
- باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد
- ( باب )
- ( ما يجب على أهل الذمة من الحدود )
- باب ما يجب على أهل الذمة من الحدود
- ( باب )
- ( كراهية قذف من ليس على الإسلام )
- باب كراهية قذف من ليس على الإسلام
- ( باب )
- ( ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود )
- باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود
- ( باب )
- ( الرجل يجب عليه الحد وهو مريض أو به قروح )
- باب الرجل يجب عليه الحد وهو مريض أو به قروح
- ( باب )
- ( حد المحارب )
- باب حد المحارب
- ( باب )
- ( من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة لا يعلم أنها محرمة )
- باب من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة لا يعلم أنها محرمة
- ( باب )
- ( من وجبت عليه حدود أحدها القتل )
- باب من وجبت عليه حدود أحدها القتل
- ( باب )
- ( من أتى حدا فلم يقم عليه الحد حتى تاب )
- باب من أتى حدا فلم يقم عليه الحد حق تاب
- ( باب )
- ( العفو عن الحدود )
- باب العفو عن الحدود
- ( باب )
- ( الرجل يعفو عن الحد ثم يرجع فيه والرجل يقول للرجل )
- ( يا ابن الفاعلة ولأمه وليان )
- باب الرجل يعفو عن الحد ثم يرجع فيه ، والرجل يقول للرجل يا ابن الفاعلة ولأمه وليان
- ( باب )
- ( أنه لا حد لمن لا حد عليه )
- ( باب )
- ( أنه لا يشفع في حد )
- باب أنه لا حد لمن لا حد عليه
- باب أنه لا يشفع في حد
- ( باب )
- ( أنه لا كفالة في حد )
- ( باب )
- ( أن الحد لا يورث )
- باب أن الحد لا يورث
- ( باب )
- ( أنه لا يمين في حد )
- ( باب )
- ( حد المرتد )
- باب أنه لا يمين في حد
- باب حد المرتد
- ( باب )
- ( حد الساحر )
- باب حد الساحر
- ( باب النوادر )
- باب النوادر
- الفهرست






