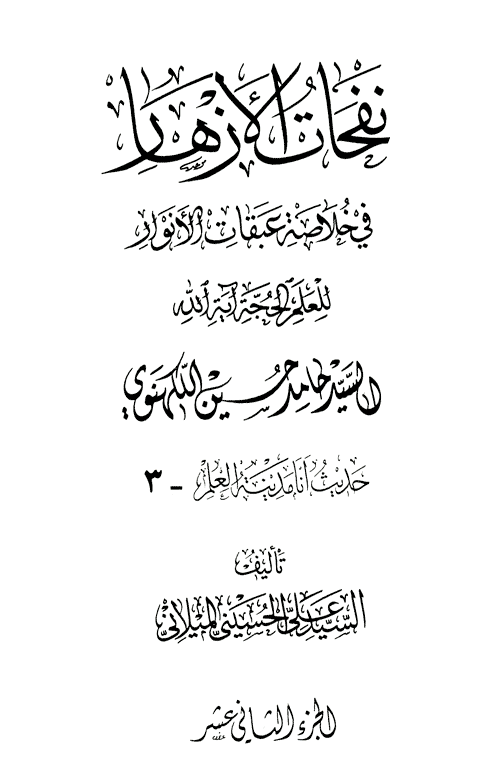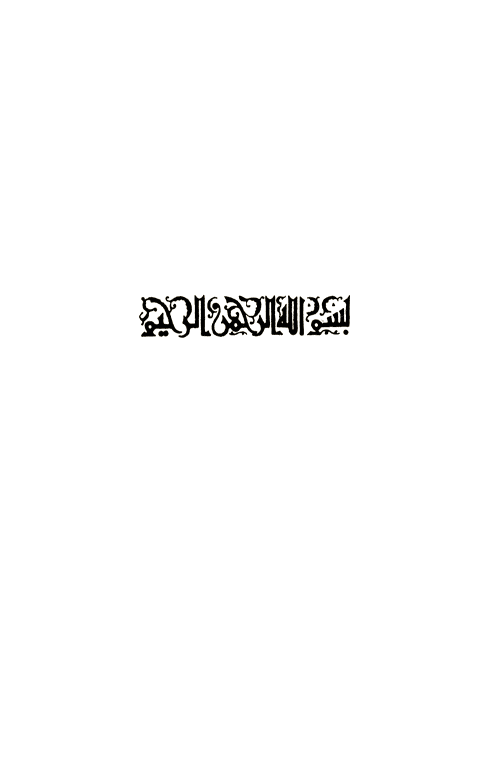نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٢
 0%
0%
 مؤلف: السيد علي الحسيني الميلاني
مؤلف: السيد علي الحسيني الميلاني
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 301

مؤلف: السيد علي الحسيني الميلاني
تصنيف: الصفحات: 301
المشاهدات: 153995
تحميل: 6728
توضيحات:
- مع ابن تيميّة الحرّاني في كلامه حول حديث « أنا مدينة العلم »
- 1 - بطلان دعوى ضعف الحديث
- ثناء ابن تيمية على ابن معين وأحمد
- اعتراف ابن تيميّة برواية الترمذي
- ثناء ابن تيميّة على الترمذي واعتماده عليه
- غلوّ ابن تيميّة في ابن جرير الطبري
- ثناء ابن تيميّة على الحاكم
- 2 - سقوط التمسّك بقدح ابن الجوزي
- 3 - قوله: « والكذب يعرف من نفس متنه »
- 4 - بطلان دعوى وجوب أن يكون المبلّغون أهل التواتر
- 5 - قوله: « خبر الواحد لا يفيد العلم الا بقرائن 1 ) قال أحمد: خبر الواحد يفيد العلم مطلقاً
- 2 ) قال الأكثر: لا يفيد العلم مطلقاً 3 ) لا حاجة إلى القرينة بعد النّص
- 4 ) لما ذا التخصيص بالقرآن والسنة المتواترة؟ 6 - الإِشارة إلى أدلّة عصمة علي عليهالسلام
- 7 - لازم قوله: هذا الحديث إنما افتراه زنديق
- من الأحاديث الدالّة على أنّ علياً مبلِّغ علوم النبي
- 8 - انتشار العلم عن علي
- المدينة المنوّرة
- مكّة المكرّمة
- الشام
- البصرة
- الكوفة
- اليمن
- مع يوسف الأعور في كلامه حول الحديث دلالة الحديث على رجحان علم الامام
- دلالته على الإحاطة بعلوم النبي دلالته على الأعلمية بطلان دعوى المساواة بين الأصحاب في العلم حديث أصحابي كالنجوم موضوع
- عدم دلالة حديث النجوم على المساواة
- إثبات العلم لكلّ الصحابة محال
- حديث مدينة العلم ثابت عن طرق الفريقين ليس للزيادة المزعومة طريق واحد موثوق به ومن الذي رواها؟
- لو ثبتت لم تكن حجةً على الامامية الأصل في الزيادة والكلمات فيه وفي واضعها
- دلالة الزّيادة على خلاف مرامهم
- تأويل لفظ « علي » من صنع الخوارج إنّه خلاف ما فهمه الناس يبطله ذكرهم الحديث في مناقب الامام
- وضع الزيادة فيه دليل بطلان تأويله طعن بعضهم في سنده دليل بطلان تأويله قول الامام: أنا باب المدينة
- إحتجاج الامام بالحديث يوم الشورى
- استدلال ابن عباس بالحديث احتجاج عمرو بن العاص به على معاوية
- قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في آخر الحديث: « فليأت عليّاً »
- القرائن في بعض الألفاظ
- شواهد الحديث تكذّب التأويل
- ردّ أعلام القوم التأويل المذكور
- مع السخاوي في كلامه حول الحديث
- دعوى إجماع الصحابة والتابعين على أفضلية الشيخين فاسدة
- لو سلّمنا انعقاده فحديث مدينة العلم وغيره يبطله عدم صحّة معنى حديث ابن عمر في المفاضلة
- عدم صحّة سند حديث ابن عمر النّظر في الطريق الأوّل
- النّظر في الطريق الثاني حديث ابن عمر بلفظٍ صريح في أفضلّية الامام
- تصريح ابن عمر بأفضلية الامام في أحاديث أخرى
- تأملات القوم في حديث ابن عمر
- رأي علي في الشيخين
- تحريفٌ من البخاري
- تحريف من أبي بكر الجوهري
- نظرة في سند حديث مختلق
- حديث مختلق آخر حديث مختلق آخر
- مع السيوطي في كلامه حول الحديث
- مع السمهودي في كلامه حول الحديث 1 - نسبة الطعن إلى البخاري والترمذي كذب
- 2 - دعوى عدم المنافاة بين الحديث وتفضيل أبي بكر باطلة 3 - دعوى شهادة الامام بتفضيل أبي بكر باطلة 4 - دعوى شهادة غير الامام بذلك باطلة 5 - دعوى شهادة الامام له بالعلم كاذبة
- 6 - دعوى كون الحق مع أبي بكر في موارد الاختلاف كاذبة 7 - الإِعتذار بقصر مدّة أبي بكر غير مسموع
- 8 - اعتراف الشيخين بأعلميّة علي ورجوعهما إليه
- مع ابن روزبهان في كلامه حول الحديث
- كلام آخر لابن روزبهان
- 1 - علي أعلم الأمة لا أنه من علماء الأمة فقط 2 - الناس محتاجون اليه كاحتياجهم الى النبي 3 - اعتراف ابن روزبهان بكون الامام وصي النبي في إبلاغ العلم
- 4 - اعترافه برواية الترمذي 5 - دفع إيراد ابن روزبهان على العلامة الحلي اسقاطهم حديث أنا مدينة العلم من صحيح الترمذي
- التّحريف في المصابيح للبغوي
- مع ابن حجر المكي في كلامه حول الحديث علي الأعلم لحديث مدينة العلم
- دعوى أنّ الحديث مطعون باطلة
- آراء العلماء في ابن الجوزي
- ردّ العلماء على طعن ابن الجوزي في حديث مدينة العلم
- تحسين ابن حجر في المنح المكيّة
- 3 - تحسين ابن حجر في تطهير الجنان
- 4 - تحسين ابن حجر في بعض فتاويه
- 5 - وأبو بكر محرابها؟! الحديث ضعفه ابن حجر نفسه
- إحداثُ المحاريب بدعة عند أهل السنة
- أول من أحدث المحراب عمر بن عبد العزيز
- واقع حال أبي بكر لا يناسب تلك النسبة الفروق بين « الباب » و« المحراب »
- 6 - قوله: « فمن أراد العلم » لا يقتضي الأعلمية قوله: « أنا مدينة العلم وعلي بابها » بوحده يقتضي الأعلمية
- هل يجوز الارجاع إلى غير الأعلم؟ ابطال توجيه ابن حجر
- 7 - حديث: أبو بكر أساسها وعمر حيطانها وعثمان سقفها هو من وضع إسماعيل الاسترآبادي السخاوي وهذا الحديث
- ابن حجر نفسه وهذا الحديث البدخشاني وهذا الحديث
- اللكهنوي وهذا الحديث أبو بكر أساسها ...!!
- وعمر حيطانها ...!!
- وعثمان سقفها ...!!
- رأي ابن حجر في تأويل « علي »
- قوله تعالى: ( هذا صِراطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ) في قراءة أهل البيت
- وحلقتها معاوية ...!! لا يصحّ عن النبي في فضل معاوية شيء
- بطلان الجملة الموضوعة معنىً
- حديث المدينة بلفظ آخر موضوع
- مع القاري في كلامه حول الحديث
- علي باب المدينة لا سواه
- حديث النجوم موضوع
- دعوى تخصيص الحديث باب القضاء
- الاشارة إلى جواب سائر كلمات القاري
- مع البنباني في كلامه حول الحديث
- دعوى تخصيص كونه باباً لغير الصحابة
- دعوى أنّ أعلم الصحابة هم الخلفاء
- أخذ الخلفاء وغيرهم من الامام
- دلالة الحديث على أنّ للمدينة باباً واحداً فقط
- مع القادري في كلامه حول الحديث
- مع عبد الحق في كلامه حول الحديث
- دعوى أنّ وجه التخصيص تميّزه بالسّعة
- لا مظاهر لصفات النبوة إلّا أهل البيت
- العلم أجلّ الصفات
- حديث النجوم موضوع
- مع ولي الله في كلامه حول الحديث
- كلام آخر لولي الله
- النظر في حديث الاقتداء
- النظر في حديث اللبن سندا
- تحقيق في حال رواته
- كتاب أبي حازم إلى الزهري
- ترجمة أبي حازم الأعرج
- حال والد الزهري وجدّه
- النظر في حديث اللبن دلالةً
- النظر في حديث القميص سنداً
- النّظر في حديث القميص دلالة
- إيقاظ وتنبيه
- دعوى مقارنة ما ورد في فضل ابن مسعود لحديث المدينة
- دعوى مقارنة ما ورد في فضل عائشة لحديث المدينة دعوى مقارنة ما ورد في فضل معاذ وأُبيّ لحديث المدينة
- توقيف فيه تعنيف
- كلام آخر لوليّ الله
- النظر في سند حديث خذوا عن الحميراء
- النظر في حديث خذوا عن الحميراء دلالة النظر في حديث الاقتداء سنداً ودلالةً النظر في حديث « رضيت لكم »
- مع الأورنق آبادي في كلامه حول الحديث
- النظر في حديث الخوخة
- ترجمة جرير بن حازم
- ترجمة عكرمة
- ترجمة إسماعيل بن أبي أويس
- مالك بن أنس تحريف البخاري في حديث الخوخة وضعف أسانيده
- النظر في حديث حذيفة في بابيّة عمر
- دعوى دلالة حديث المدينة على عدم تملّك بيت النّبوة شيئاً من المال
- الأئمة الأطهار في العلم سواء
- لم يرث العلم إلّا الأئمة الأطهار
- مع القاضي ثناء الله في كلامه حول الحديث
- الحملُ على العلوم الباطنة باطلٌ
- حديث « أنا مدينة الفقه وعلي بابها »
- قدح حديث النجوم
- مع الدهلوي في كلامه حول الحديث
- الفهرس