جنّة الحوادث في شرح زيارة وارث
 0%
0%
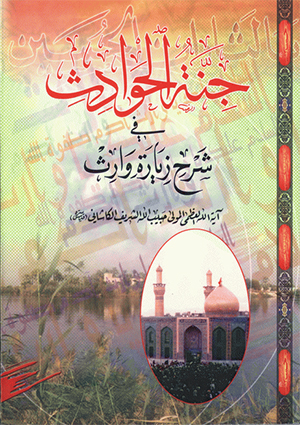 مؤلف: آية الله حبيب الله الشريف الكاشانيّ (قدس سره)
مؤلف: آية الله حبيب الله الشريف الكاشانيّ (قدس سره)
تصنيف: متون الأدعية والزيارات
ISBN: 964-94216-1-0
الصفحات: 195
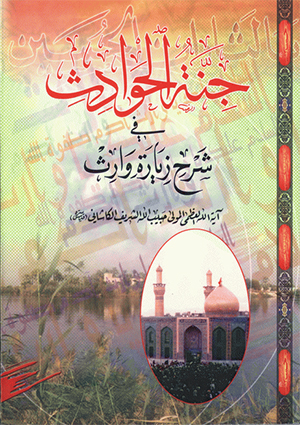
مؤلف: آية الله حبيب الله الشريف الكاشانيّ (قدس سره)
تصنيف: ISBN: 964-94216-1-0
الصفحات: 195
المشاهدات: 28532
تحميل: 6617
توضيحات:
- الإهداء
- مقدّمة المحقّق
- ترجمة الشارح
- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ آدَمَ صِفْوَةِ اللهِ
- الموضع الثاني في تفسير كونه عليه السّلام وارثاً للأنبياء والأوصياء
- الموضع الثالث في تفسير صفوة الله
- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ نُوحٍ نَبِيِّ اللهِ
- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ اِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللهِ
- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُوسىٰ كَلِيمِ اللهِ
- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ عِيسىٰ رُوحِ اللهِ
- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُحَمَّدٍ حَبِيبِ اللهِ
- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِیِّ اللهِ
- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ مُحَمّد المُصْطفىٰ،
- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ عَليِّ الْمُرْتَضىٰ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ فَاطِمَةَ الزَّهْراءِ،
- السَّلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ خَدِيجَةَ الكُبْرىٰ
- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ثَارَ اللهِ وَابْنَ ثَارِهِ وَالْوِتْرَ الْمَوْتُورَ
- أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ وأَطَعْتَ اللهَ وَرَسُولهُ حَتّىٰ أَتَاكَ الْيَقِينُ
- فَلَعَنَ اللهُ أُمَّةً قَتَلَتْكَ، وَلَعَنَ اللهُ أُمَّةً ظَلَمَتْكَ
- وَلَعَنَ اللهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذٰلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ
- يَا مَوْلَايَ يَا أَبَا عَبْدِاللهِ
- أَشْهَدُ أَنَّكَ كُنْتَ نُوراً فِي الْأَصْلَابِ الشَّامِخَةِ
- وَأَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ دَعَائِمِ الدِّينِ، وَأَرْكَانِ الْمُؤْمِنِينَ
- وَأَشْهَدُ أَنَّكَ الْإِمَامُ الْبَرُّ التَّقِيُّ الرَّضِيُّ الزَّكِيُّ الْهَادِي الْمَهْدِيُّ
- وَأَشْهَدُ أَنَّ الْأَئِّمَةَ مِنْ وُلْدِكَ كَلِمَةُ التَّقْوىٰ، وَأَعْلَامُ الْهُدىٰ، وَالْعُروَةُ الْوُثْقىٰ، [ وَالْحُجَّةُ عَلىٰ أَهْلِ الدُّنْيَا ]
- وَأُشْهِدُ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَنْبِيَاءَهُ وَرُسُلَهُ أَنّي بِكُمْ مُؤْمِنٌ وَبِاِيَابِكُمْ مُوقِنٌ بِشَرَايِعِ دِيني وَخَوَاتِيمِ عَمَلي، وَقَلْبي لِقَلْبِكُمْ سِلْمٌ وَأَمْري لِأَمْرِكُمْ مُتَّبِعٌ
- صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَعَلىٰ أَرْوَاحِكُمْ وَعَلىٰ أَجْسَادِكُمْ وَعَلىٰ [أَجْسَامِكُمْ] وَعَلىٰ شَاهِدِكُمْ وَعَلىٰ غَائِبِكُمْ وَعَلىٰ ظَاهِرِكُمْ وَعَلىٰ بَاطِنِكُمْ
- مصادر التحقيق
- الفهرس






