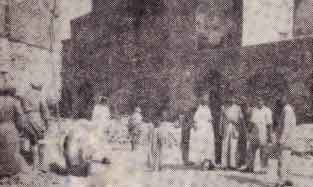بغية النبلاء في تاريخ كربلاء
 20%
20%
 مؤلف: السيد عبد الحسين الكليدار آل طعمة
مؤلف: السيد عبد الحسين الكليدار آل طعمة
الناشر: مطبعة الإرشاد
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 197
- مقدّمة المؤلّف
- تأريخ كربلاء منذ القدم إلى القرن الثالث عشر
- كربلاء في القرن الثالث عشر
- الدور الثاني
- الدور الثالث
- حادثة المناخور
- حادثة نجيب باشا
- فتنة علي هدلة
- كربلاء في القرن الرابع عشر
- وقعة الزهاوي للعجم
- حادثة حمزة بك
- ثورة العشرين
- يوم ورود الشعرات النبوية الشريفة إلى كربلاء
- وصف الحائر الحسيني
- دفن بني أسد للجثث الطاهرة
- تاريخ بناء المشهد الحسيني
- إيضاح ما يوجد في خارطة كربلاء من المواقع
- أنهار كربلاء
- نهر العلقمي
- آقا محمّد شاه القاجاري
- نهر نينوى
- النهر الغازاني
- النهر السليماني (الحسينيّة)
- الطفّ
- الحائر
- القرى التي كانت تحف بكربلاء يوم ورود الحسين (عليه السّلام) لها
- نينوى، والغاضرية
- شفية
- العقر
- النواويس
- المصادر التي عول عليها المؤلّف في الشجرة
- ترجمة الأعلام التي وردت أسماؤهم في الشجرة
- (١) محمد العابد
- مزار محمّد العابد في شيراز
- (٢) تاج الدين إبراهيم المجاب
- (٣) أبو الفائز محمّد الخامس
- (٤) السيد أحمد الثاني
- (٥) السيد طعمة الأوّل
- (٦) السيد طعمة الثاني
- (٧) السيد طعمة الثالث
- (٨) السيد نعمة الله
- (٩) السيد يحيى الثاني ضياء الدين (نقيب الأشراف)
- (١٠) السيد درويش
- (١١) السيد علي الثالث
- أخبار عن الحائر وزائريه في العصر العباسي
- (الأمالي للطوسي)
- كرب الرشيد لقبر الحسين
- (زهر الآداب للحصري)
- زيارة منصور النمري
- (تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي)
- زيارة ابن الهبارية
- (الأمالي للطوسي)
- هدم المتوكّل لقبر الحسين (عليه السّلام)
- ديوان الأبله البغدادي
- نشوار المحاضرة للتنوخي
- زيارة الحائر في الربع الأوّل من القرن الرابع
- الفرج بعد الشدّة للتنوخي
- نشوار المحاضرة للتنوخي
- إرشاد الأريب لياقوت
- ورود تابوت أبي العباس الملقّب بالكافي الأوحد
- قصيدة الصابي بتهنئة عضد الدولة عند عودته من الزيارة
- حديث الناشئ
- الملاحق والمستدركات
- ملحق رقم (١)
- تعميرات الحائر الحسيني من أواخر القرن الثالث عشر إلى الوقت الحاضر
- ترميم صندوق الخاتم
- ترميم الجبهة الشرقيّة من الصحن
- أبواب الصحن الحسيني
- ملحق رقم (٢)
- تعريف بالمصادر الفارسيّة التي اعتمد عليها المؤلّف
- ١ - تأريخ جهان كشاي الجويني
- ٢ - تأريخ وصاف
- ٣ - نزهة القلوب
- ٤ - تزوكات تيموري
- ٥ - حبيب السير
- ٦ - روضة الصفا في سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء
- ٧ - زينة المجالس
- ٨ - دبستان المذاهب
- ٩ - تأريخ عالم آراي عباسي
- ١٠ - سلطان التواريخ
- ١١ - التأريخ النادري
- ١٢ - مجالس المؤمنين
- ١٣ - دلائل الدين
- ١٤ - تحفة العالم
- ١٥ - تأريخ كيتي كشا
- ١٦ - فوائد الصفويّة
- ١٧ - مسير طالبي
- ١٨ - روضة الصفاي ناصري
- ١٩ - فارسنامه ناصري
- ٢٠ - مجلد القاجارية من ناسخ التواريخ (تأريخ قاجار)
- ٢١ - زنبيل فرهاد
- ٢٢ - رياض السياحة
- ٢٣ - ترجمة فتوح ابن أعثم الكوفي
- ٢٤ - الكامل البهائي
- ملحق رقم (٣)
- التعريف ببعض المخطوطات العربيّة التي أخذ منها المؤلّف
- ١ - سر السلسلة العلوية
- ٢ - المجدي
- ٣ - مشجر الشيخ شرف العبيدلي النسابة
- ٤ - ديوان الأبله البغدادي
- ٥ - الدرّ النظيم في مناقب الأئمّة اللهاميم
- ٦ - شدّ الإزار في حطّ الأوزار عن زوار المزار
- ٧ - عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب
- ٨ - تحفة الأزهار وزلال الأنهار في نسب أبناء الأئمّة الأطهار
- ملحق رقم (٤)
- ١ - الاستدراكات