فاجعة الطف أبعادها - ثمراتها - توقيتها
 8%
8%
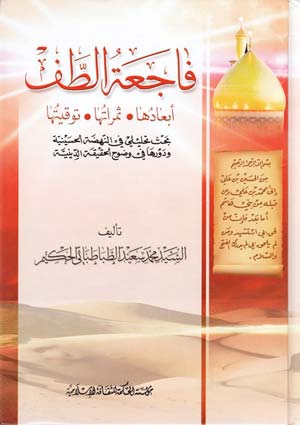 مؤلف: السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
مؤلف: السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 672
- المقدّمة
- نظرية أنّ التخطيط لواقعة الطفّ بَشريّ
- نظرية أنّ التخطيط للواقعة إلهي
- تأكيد النصوص على أنّ التخطيط لفاجعة الطفّ إلهي
- الشواهد المؤكّدة لكون التخطيط للفاجعة إلهي
- إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت بالفاجعة قبل وقوعها
- توقّع الناس للفاجعة قبل وقوعها
- بعض التفاصيل المناسبة لانتهاء النهضة بالفاجعة
- توقّع الإمام الحسين (عليه السّلام) أنّ عاقبة نهضته القتل
- الحثّ على نصر الإمام الحسين (عليه السّلام) والتأنيب على خذلانه
- الإمام الحسين (عليه السّلام) مأمور بنهضته عالم بمصيره
- الشواهد على أنّه (عليه السّلام) لم يتحرّ مظان السلامة
- إخبار الإمام الحسين (عليه السّلام) لمَنْ معه بخذلان الناس له
- تهيؤ الإمام الحسين (عليه السّلام) للقاء الحرّ وأصحابه
- اتفاقه (عليه السّلام) مع الحرّ في الطريق
- امتناعه (عليه السّلام) من الذهاب لجبل طيء
- تصريحه (عليه السّلام) حين وصوله كربلاء بما عُهد إليه
- تنبيهه (عليه السّلام) لظلامته وتمسّكه بموقفه
- الظروف التي أحاطت بالنهضة لا تناسب انتصاره عسكري
- ظهور الإحراج عليه (عليه السّلام) مع ناصحيه
- اعتذاره (عليه السّلام) برؤياه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنّه ماضٍ لما أمره
- إخباره (عليه السّلام) لأخيه بما أمره به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرؤيا
- بعض شواهد إصراره (عليه السّلام) على الخروج للعراق مع علمه بمصيره
- رواية الفريقين للمضامين السابقة شاهد بصحته
- رواية الفريقين إخبار الأنبياء السابقين بالفاجعة
- كتابه (عليه السّلام) إلى بني هاشم بالفتح الذي يحقّقه
- إخبار الإمام السجّاد (عليه السّلام) بأنّ أباه (عليه السّلام) هو الغالب
- خلود الفاجعة يناسب أهميتها
- لا موجب لإطالة الكلام في تفاصيل النهضة الشريفة
- عظمة الإمام الحسين (عليه السّلام) وروح التضحية التي يحمله
- تحلّي الإمام الحسين (عليه السّلام) بالعاطفة
- الموقف المشرّف لِمَنْ في ركبه من عائلته وصحبه
- المقصد الأوّل: في أبعاد فاجعة الطفّ وعمقها وردود الفعل المباشرة لها
- الفصل الأوّل: في أبعاد فاجعة الطفّ وعمقه
- تمهيد
- استنكار جمهور المسلمين لعهد معاوية ليزيد
- كان الإمام الحسين (عليه السّلام) مسالماً في دعوته للإصلاح
- قتل الإمام الحسين (عليه السّلام) هو الجريمة الأولى
- الإمام الحسين (عليه السّلام) هو الرجل الأوّل في المسلمين
- جريمة قتل أهل البيت (عليهم السّلام) الذين معه
- قتل الثلّة الصالحة من أصحاب الحسين (عليه السّلام) معه
- قتل الأطفال بما فيهم الرضيع
- التضييق على ركب الإمام الحسين (عليه السّلام) ومنعهم من الماء
- انتهاك حرمة العائلة النبويّة
- انتهاك حرمة الأجساد الشريفة بعد القتل
- النيل من الإمام الحسين (عليه السّلام) وأهل بيته
- الإمام الحسين (عليه السلام) بقية أصحاب الكساء
- تذكّر الناس أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره عن عظم الجريمة
- تشفّي الأمويين بالفاجعة ثأراً لأسلافهم المشركين
- الجو الديني الذي عاشه الإمام الحسين (عليه السّلام) وأصحابه
- الأحداث الكاشفة عن ارتباط الفاجعة بالله تعالى
- الرؤى المؤكّدة لعظم الجريمة
- نوح الجنّ على الإمام الحسين (عليه السّلام)
- التنكيل الإلهي بقتلته (عليه السّلام) وما حصل فيما سلب منه
- الإمام الحسين (عليه السّلام) ثار الله تعالى وابن ثاره
- الفصل الثاني: في ردود الفعل المباشرة لفاجعة الطف
- المقام الأوّل: في رد الفعل من قبل الناس
- إنكار بعض الصحابة على يزيد وابن زياد
- إنكار يحيى بن الحكم
- إنكار ابن عفيف الأزدي على ابن زياد في مسجد الكوفة
- إنكار امرأة من آل بكر بن وائل
- موقف جمهور أهل الكوفة
- موقف جمهور أهل المدينة المنوّرة
- موقف أهل المدينة عند رجوع العائلة الثاكلة إليه
- موقف الناس في الشام
- وقع الحدث في أمصار المسلمين البعيدة
- محاولة الإمام الحسين (عليه السّلام) نشر مناقب أهل البيت (عليهم السّلام)
- جهود العائلة الثاكلة في كشف الحقيقة وتهييج العواطف
- فاجعة الطفّ أشدّ جرائم يزيد وقعاً في نفوس المسلمين
- ندم جماعة من المشاركين في المعركة
- ندم عمر بن سعد وموقف الناس منه
- ندم جماعة لتركهم نصرة الإمام الحسين (عليه السّلام)
- استغلال المعارضة للفاجعة ضدّ الحكم الأموي
- المقام الثاني: في موقف السلطة نتيجة ردّ الفعل المذكور وانقلاب موقفها من الحدث ومن عائلة الإمام الحسين (صلوات الله عليه)
- شواهد أمر يزيد بقتل الإمام الحسين (عليه السّلام)
- محاولة يزيد التنصّل من الجريمة واستنكاره لها
- محاولة ابن زياد التنصّل من الجريمة وشعوره بالخطأ
- موقف الحكّام إذا أدركوا سوء عاقبة جرائمهم عليهم
- موقف معاوية ممّا فعله بسر بن أرطاة
- موقف عبد الملك بن مروان من الفاجعة
- إدراك الوليد بن عتبة سوء أثر الجريمة على الأمويين
- موقف معاوية المسبق من الجريمة
- المقصد الثاني: في ثمرات فاجعة الطفّ وفوائدها
- الفصل الأوّل: فيما جناه الدين من ثمرات فاجعة الطفّ
- الهدف الأوّل للإمام الحسين (عليه السّلام)
- الزيارات المتضمّنة أنّ الهدف إيضاح معالم الدين
- أهمية بقاء معالم الدين ووضوح حجّته
- تميّز الإسلام بما أوجب إيضاح معالمه وبقاء حجّته
- ما يتوقّف عليه بقاء معالم الدين الحق ووضوح حجّته
- المطلب الأوّل: فيما كسبه الإسلام بكيانه العام
- تمهيد
- يجب بقاء الدين الحق واضح المعالم ظاهر الحجّة
- لا بدّ من رعاية المعصوم للدين
- استغلال السلطة المنحرفة الدعوة ومبادئها لصالحها
- غلبة الباطل لا توجب ضياع الدين الحقّ وخفاء حجّته
- لا ملزم بوضوح معالم الدين بعد نسخه
- كون الإسلام خاتم الأديان يستلزم بقاء معالمه ووضوح حجّته
- المبحث الأوّل: فيما من شأنه أن يترتّب على انحراف مسار
- السلطة في الإسلام لو لم يكبح جماحها
- وجوب معرفة الإمام والإذعان بإمامته
- وجوب طاعة الإمام وموالاته والنصيحة له
- لزوم جماعة المسلمين والمؤمنين وحرمة التفرّق
- أهمية هذه الأمور في نظم أمر الدين والمسلمين
- طاعة الإمام المعصوم مأمونة العاقبة على الدين والمسلمين
- طاعة الإمام ولزوم جماعته مدعاة للطفّ الإلهي
- انحراف مسار السلطة في الإسلام
- إنكار أمير المؤمنين والزهراء (عليهما السّلام) لِما حصل
- اضطرار أمير المؤمنين (عليه السّلام) للمسالمة
- أثر الفتوح في تركز الإسلام واحترام رموز السلطة
- غياب الإسلام الحقّ ورموزه عن ذاكرة المسلمين
- دعم أمير المؤمنين (عليه السّلام) السلطة اهتماماً بكيان الإسلام
- تقييم أمير المؤمنين (عليه السّلام) للأوضاع
- استغلال الألقاب المناسبة لشرعية السلطة ونقلها عن أهلها
- عدم شرعية استغلال السلطة لهذه الألقاب
- اختصاص لقب أمير المؤمنين بالإمام علي (عليه السّلام)
- تحجير السلطة على السُنّة النبويّة
- قسوة السلطة في تنفيذ مشروعها
- سيرة عمر أيّام ولايته
- وضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصالح السلطة
- كلام أمير المؤمنين (عليه السّلام) في أسباب اختلاف الحديث
- شكوى أمير المؤمنين (عليه السّلام) من التحريف وتعريضه بالمحرّفين
- تأكيد السلطة على أهميّة الإمامة وعلى الطاعة ولزوم الجماعة
- تبدّل موقف العباسيين من خلافة الأمويين
- أثر هذه الثقافة على العامّة
- أثر هذه الثقافة في إفريقية
- موقف عبد الله بن عمر من الإمامة والجماعة
- الأحاديث والفتاوى في دعم هذا الاتجاه
- مشابهة الاتجاه المذكور للتعاليم المسيحية الحالية
- حديث أمير المؤمنين (عليه السّلام) في حقوق الوالي والرعية
- ما تقتضيه القاعدة في البيعة
- ما آل إليه أمر وجوب البيعة والطاعة ولزوم الجماعة
- اختلاف الأُمّة في الحقّ خير من اتفاقها على الباطل
- استعانة السلطة بالمنافقين وحديثي الإسلام
- السلطة تمكّن للأمويين وخصوصاً معاوية
- ظهور الاستهتار من المنافقين
- موقف أُبي بن كعب وموته
- تبرير السلطة بعض مواقفها بالقضاء والقدر
- قيام كيان الإسلام العام على الطاعة العمياء للسلطة
- تعرّض الدين للتحريف
- جهل المتصدّين للفتوى والقضاء
- ظهور الاختلاف في الحديث والقضاء والفتوى
- كلام أمير المؤمنين (عليه السّلام) حول اختلاف القضاء
- ظهور الجرأة على الفتوى والقضاء
- شكوى أمير المؤمنين (عليه السّلام) من أوضاع الأُمّة
- ظهور الابتداع في الدين ومخالفة نصوصه
- تشويه الحقائق في التاريخ والمناقب والمثالب
- ظهور حجم الخطر بملاحظة ثقافة الأمويين
- نماذج من التحريف في العهد الأموي
- المبحث الثاني: في جهود أهل البيت عليهم السلام في كبح جماح الانحراف وما كسبه الإسلام بكيانه العام من ذلك
- المقام الأوّل: في جهود أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) وجهود الخاصّة من الصحابة والتابعين الذين كانوا معه
- تخوّف عمر بن الخطاب من أطماع قريش
- تحجير عمر على كبار الصحابة
- توقّف أهل البيت (عليهم السّلام) عن تنبيه عامّة المسلمين لحقّهم في الخلافة
- إحساس عمر بأنّ الاستقرار على وشك النهاية
- تنبؤ الصديقة الزهراء (عليها السّلام) باضطراب أوضاع المسلمين
- مجمل الأوضاع في أوائل عهد عثمان
- غفلة العامّة عن ابتناء بيعة عثمان على الانحراف
- مدى اندفاع العامّة مع السلطة في تلك الفترة
- اختلاف عثمان عن عمر في الحزم والسلوك
- ظهور الإنكار على عثمان من عامّة المسلمين
- تحقّق الجو المناسب لإظهار مقام أمير المؤمنين (عليه السّلام) وبيان ظلامته
- جهود الخاصة في التعريف بمقامه (عليه السّلام) وكشف الحقيقة
- توجّهات المعارضة لعثمان
- مقتل عثمان بعد فشل مساعي أمير المؤمنين (عليه السّلام) لحلّ الأزمة
- مطالبة الجماهير ببيعة أمير المؤمنين (عليه السّلام)
- إباء أمير المؤمنين (عليه السّلام) البيعة تنبئه بالمستقبل القاتم
- بيعة أمير المؤمنين (عليه السّلام) وما استتبعها من تداعيات
- قد يبدو فشل أمير المؤمنين (عليه السّلام) في تسلّمه للسلطة
- علمه (عليه السّلام) بفشل مشروع الإصلاح الجذري
- أهداف أمير المؤمنين (عليه السّلام) من تسلّمه للسلطة
- سعيه (عليه السّلام) لإيضاح الحقائق الدينية
- إصحاره (عليه السّلام) بالحقيقة وبحقّه في الخلافة وبظلامته
- إيضاحه للمراد من الجماعة التي يجب لزومها
- مميّزاته الشخصية ساعدت على تأثيره وسماع دعوته
- إيمان ثلّة من الخاصّة بدعوته (عليه السّلام) وتضحيتهم في سبيلها
- العقبة الكؤود في طريق الدعوة احترام الأوّلين
- خطبة له (عليه السّلام) يستعرض فيها كثيراً من البدع
- إيضاحه (عليه السّلام) لأحكام حرب أهل القبلة
- سيرته (عليه السّلام) في حروبه صارت سنّة للمسلمين
- إسلام الباغي يعصمه من الرق ويعصم ماله
- سقوط حرمة الباغي وانقطاع العصمة معه
- الخلاصة في هدفه (عليه السّلام) من تولي السلطة
- قيامه (عليه السّلام) بالأمر بعد عثمان بعهد من الله تعالى
- كلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة
- المقام الثاني: في مواجهة السلطة لجهود أمير المؤمنين (عليه السّلام) وخاصته
- اهتمام معاوية بالقضاء على خط أهل البيت (عليهم السّلام)
- إدراك معاوية قوة خط أهل البيت (عليهم السّلام) عقائدي
- دعم العقل والدليل لخط أهل البيت (عليهم السّلام)
- انشداد الناس عاطفياً لخط أهل البيت (عليهم السّلام)
- ظهور فشل نظرية عدم النص في الخلافة
- تنبؤ سيدة النساء فاطمة (عليه السّلام) وغيرها بنتائج الانحراف
- انتشار التشيع إذا لم تزرع الألغام في طريقه
- الألغام التي زرعها معاوية في طريق التشيع
- التنكيل بالشيعة
- أثر التنكيل بالشيعة على التشيع
- عود التحجير على السنة النبوية
- المنع من رواية الأحاديث المؤيدة لخط أهل البيت (عليهم السّلام)
- محاورة معاوية مع ابن عباس
- افتراء الأحاديث القادحة في أهل البيت (عليهم السّلام)
- موقف الجمهور من الأحاديث المذكورة
- افتراء الأحاديث في فضل الصحابة والخلفاء الأولين
- تقديس الأوّلين يقف حاجزاً دون تقبّل النصّ
- ضعف غلواء تقديس الشيخين في أواخر العهد الأموي
- مهاجمة العباسيين للأوّلين في بدء الدعوة
- تراجع المنصور وتقديمه للشيخين
- اعتراف المنصور ومَنْ بعده بشرعية خلافة الأمويين
- تراجع المأمون عن موقف آبائه
- تأكّد عدالة الصحابة وتقديس الشيخين في عهد المتوكّل
- قوّة خطّ الخلافة عند الجمهور يفضي إلى تحكيم السلطة في الدين
- تفاقم الخطر بتحويل الخلافة إلى قيصرية أموية
- حديث المغيرة بن شعبة عن خطر البيعة ليزيد
- ما حصل هو النتيجة الطبيعية لخروج السلطة عن موضعها
- المقام الثالث: في أثر فاجعة الطفّ في الإسلام بكيانه العام
- أحكم معاوية بناء دولة قوية
- امتعاض ذوي الدين من انحراف السلطة عن تعاليمه
- مَنْ يرى إمكان إصلاح السلطة وتعديل مسارها
- مَنْ يرى تجنّب الاحتكاك بالسلطة حفاظاً على الموجود
- موقف أهل البيت (عليهم السّلام) إزاء المشكلة
- بيعة يزيد تعرض جهود أمير المؤمنين (عليه السّلام) للخطر
- عدم تبلور مفهوم التقيّة
- لم يخرج على سلطة الأمويين إلّا الخوارج الذين سقط اعتبارهم
- موقف الشيعة من الأوّلين يحول دون تفاعل الجمهور معهم
- التفاف السلطة على الخاصة لإضعاف تأثيرهم على الجمهور
- شرعية السلطة تيسّر لها التدرّج في تحريف الدين
- تبعية الدين للسلطة تخفف وقعه في نفوسهم
- قد ينتهي التحريف بتحول الدين إلى أساطير وخرافات
- ضرورة إحراج السلطة بموقف يلجئها لمغامرة سابقة لأوانها
- سنوح الفرصة لاتخاذ الموقف المذكور بعد معاوية
- اقتحام السلطة له (عليه السّلام) يزيدها جرأة على انتهاك الحرمات
- استهتار السلطة بعد سقوط شرعيتها لا يضرّ بالدين
- أثر الفاجعة في حدّة الخلاف بين الشيعة وخصومهم
- دفع محاذير الاختلاف
- مواقف الأنبياء والأوصياء وجميع المصلحين
- المقارنة بين دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفاجعة الطفّ
- لا بدّ من حصول الخلاف بين المسلمين بسبب الانحراف
- محذور إضعاف الدولة العربية والإسلامية
- الدولة بتركيبتها معرّضة للضعف والانهيار
- لا أهمية للدولة العربية في منظور الإسلام
- لو شكر العرب النعمة
- إظهار دعوة الإسلام الحقّ أهم من قوّة دولته
- حقّقت فاجعة الطفّ هدفها على الوجه الأكمل
- تداعيات فاجعة الطفّ في المراحل اللاحقة
- ثورة أهل المدينة وعبد الله بن الزبير
- موت يزيد بن معاوية
- إعلان معاوية بن يزيد عن جرائم جدّه وأبيه
- انتقام الأمويين من مؤدّب معاوية بن يزيد
- انهيار دولة آل أبي سفيان
- اختلاف الأمويين وتعدد الاتجاهات في العالم الإسلامي
- تنبؤ الصديقة فاطمة (عليها السّلام) بما آلت إليه الأمور
- أهمية الفترة الانتقالية التي استمرت عشر سنين
- وضوح عزل الدين في الصراع على السلطة وفي كيانها
- اتضاح أنّ بيعة الخليفة لا تقتضي شرعية خلافته
- اتضاح أنّ وجوب الطاعة ولزوم الجماعة لا يعني الانصياع للسلطة
- تخبّط الجمهور في تحديد وجوب الطاعة ولزوم الجماعة
- تناسق مفهوم الإمامة والطاعة والجماعة عند الإمامية
- الخروج على السلطة لم يَعُدْ يختصّ بالخوارج
- صارت الإمامة عند الجمهور دنيوية لا دينية
- كسر طوق الضغط الثقافي في الفترة الانتقالية
- مكسب التشيّع نتيجة كسر طوق الضغط الثقافي
- التوجّه الديني في المجتمع الإسلامي نتيجة فاجعة الطفّ
- حاجة المجتمع الإسلامي لمتخصصين في الثقافة الدينية
- أهمية دور رجال الشيعة في مجال التخصص الديني
- عدم اقتصار الأمر على الشيعة
- ظهور طبقة الفقهاء والمحدّثين
- الاتفاق على انحصار مرجعية الدين بالكتاب والسُنّة
- تعامل السلطة مع الواقع الجديد بتنسيق وحذر
- إقدام السلطة على تدوين السُنّة
- تبنّي الخلفاء لبعض الفقهاء لكسب الشرعية منهم
- مكسب الدين نتيجة هذين الأمرين
- موقف مالك بن أنس صاحب المذهب
- قوّة الكيان الشيعي نتيجة ما سبق
- تحوّل مسار الثقافة الدينية بعد الفترة الانتقالية
- عقدة احترام سُنّة الشيخين
- موقف عمر بن عبد العزيز
- التغلّب أخيراً على عقدة سيرة الشيخين
- موقف الجمهور أخيراً من سُنّة الشيخين
- المطلب الثاني: فيما كسبه التشيّع لأهل البيت (عليهم السّلام) بخصوصيته
- المقام الأوّل: في مكسب التشيّع من حيثية الاستدلال
- اعتماد التشيّع بالدرجة الأولى على الكتاب والسُنّة
- انحصار المرجعية في الدين بالكتاب والسُنّة انتصار للتشيّع
- الطرق الملتوية التي سلكها خصوم التشيّع لتضييع هذا الانتصار
- رفض الإمام الحسين (عليه السّلام) نظام الجمهور في الخلافة
- المقام الثاني: في الجانب العاطفي
- نهضة الإمام الحسين (عليه السّلام) شيعية الاتجاه
- فوز التشيّع بشرف التضحية في أعظم ملحمة دينية
- نقمة الظالمين على الشيعة في إحياء فاجعة الطفّ
- فاجعة الطفّ زعزعت شرعية نظام الخلافة عند الجمهور
- فاجعة الطفّ هي العقبة الكؤود أمام نظام الخلافة
- موقف بعض علماء الجمهور من إحياء الفاجعة
- كلام الغزالي
- كلام التفتازاني
- كلام الربيع بن نافع الحلبي حول معاوية
- موقف الغلاة لم يمنع الشيعة من ذكر كرامات أهل البيت (عليهم السّلام)
- محاولة كثير من الجمهور الدفاع للظالمين
- الدفاع عن الظالمين يصبّ في صالح التشيّع
- المقام الثالث: في الإعلام والإعلان عن دعوة التشيّع ونشر ثقافته
- اهتمام الشيعة بإحياء الفاجعة وجميع مناسبات أهل البيت (عليهم السّلام)
- منع الظالمين من إحياء مناسبات أهل البيت (عليهم السّلام)
- أثر المنع المذكور على موقف الشيعة
- أثر إحياء المناسبات المذكورة في حيوية الشيعة ونشاطهم
- أثر هذا الإحياء في جمع شمل الشيعة وتقوية روابطهم
- أثر الإحياء المذكور في تثبيت هوية الشيعة
- نشر الثقافة العامّة والدينية بسبب الإحياء المذكور
- تأثير إحياء تلك المناسبات في إصلاح الشيعة نسبياً
- إيصال مفاهيم التشيّع بإحياء تلك المناسبات
- خلود دعوة التشيّع بإحياء هذه المناسبات
- فاجعة الطفّ نقطة تحول مهمة في صالح التشيّع
- الفصل الثاني: في العبر التي تستخلص من فاجعة الطفّ
- المقام الأوّل: في آليّة العمل
- سلامة آليّة العمل وشرفه
- على مدّعي الإصلاح التزام سلامة آليّة العمل
- لا يتابع مدّعي الإصلاح مع عدم سلامة آليّة العمل
- المقام الثاني: في النتائج
- كشفت فاجعة الطفّ عن تعذّر إصلاح المجتمع بالوجه الكامل
- لا ينبغي الاغترار باندفاعات الناس العاطفية
- ينحصر الأمر بمحاولة الإصلاح النسبي
- مسألة الأئمة المتأخرين عليهم السلام للسلطة
- حديث سدير الصيرفي
- دعوى أنّ ذلك لا يتناسب مع قابلية الإسلام للتطبيق
- دفع الدعوى المذكورة
- صلاح المجتمع مدعاة للتسديد والفيض الإلهي
- إنّما يتعذّر الإصلاح الكامل بعد حصول الانحراف
- زيادة الأمر تعقّداً في عصر الغيبة
- لا يسقط الميسور من الإصلاح بالمعسور
- المقصد الثالث: في توقيت فاجعة الطفّ
- الفصل الأوّل: في موقف أمير المؤمنين (عليه السّلام)
- اهتمام أمير المؤمنين (عليه السّلام) بحفظ كيان الإسلام العام
- اهتمامه (عليه السّلام) بالحفاظ على حياته وحياة الثلّة الصالحة
- الصراع الحاد بين الصدر الأوّل يعرّض الكيان الإسلامي للانهيار
- قوّة الكيان الإسلامي العام في عصر الإمام الحسين (عليه السّلام)
- الصراع الحاد يعرّض الخاصة للخطر
- تركّز دعوة التشيّع في عصر الإمام الحسين (عليه السّلام)
- حاول أمير المؤمنين (عليه السّلام) تعديل مسار السلطة لكنّه فقد الناصر
- دعوى أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) فرّط ولم يستبق الأحداث
- الجواب عن الدعوى المذكورة
- حديث لأمير المؤمنين (عليه السّلام) في تقييم الأوضاع
- الفصل الثاني: في موقف الإمام الحسن (عليه السّلام)
- المقام الأوّل: في صلح الإمام الحسن (عليه السّلام) مع معاوية
- تعذّر انتصار الإمام الحسن (عليه السّلام) عسكرياً
- خطبة الإمام الحسن (عليه السّلام)
- مخاطر الانكسار العسكري على دعوة الحقّ وحملتها
- تصريحات الإمام الحسن وبقيّة الأئمّة (عليهم السّلام) في توجيه الصلح
- لا مجال لاستمرار الإمام (عليه السّلام) في الحرب حتى النفس الأخير
- تأييد الإمام الحسين (عليه السّلام) لموقف الإمام الحسن (عليه السّلام)
- عظمة الإمام الحسن (عليه السّلام) في موقفه
- المقام الثاني: في عدم مواجهة الإمام الحسن (عليه السّلام) لمعاوية بعد ظهور غدره
- تحرّك الشيعة في حياة الإمام الحسن (عليه السّلام)
- تقوية معاوية لسلطانه في فترة حكمه
- استغلال معاوية للعهد
- موقف الإمام الحسين (عليه السّلام) في عهد معاوية بعد أن تقلّد الإمامة
- الفصل الثالث: في موقف الأئمّة من ذرية الحسين (عليه السّلام)
- لا موجب للتضحية بعد فاجعة الطفّ
- اهتمام الأئمّة (عليهم السّلام) بالحفاظ على شيعتهم
- اهتمام الأئمّة (عليهم السّلام) بتقوية كيان الشيعة
- التأكيد على تعذّر تعديل مسار السلطة ولزوم مهادنتها
- ثمرات مهادنة السلطة
- التركيز على فاجعة الطفّ وعلى ظلامة أهل البيت (عليهم السّلام)
- التأكيد على زيارة الإمام الحسين (عليه السّلام) وجميع أهل البيت (عليهم السّلام)
- حديث معاوية بن وهب
- تحقيق الوعد الإلهي ببقاء قبره الشريف علماً للمؤمنين
- تجديد الذكرى بمرور السُنّة
- شدّ الشيعة نحو الإمام الحسين (عليه السّلام) بمختلف الوجوه
- المدّ الإلهي والكرامات الباهرة
- الحكمة في التأكيد المذكور
- التأكيد على أهمّية الإمامة في الدين وبيان ضوابطها
- دعم مقام الإمامة بالكرامات والمعاجز
- اعتراف غير الشيعة بكرامات أهل البيت (عليهم السّلام)
- التأكيد على شدّة جريمة خصوم أهل البيت (عليهم السّلام)
- التركيز على الارتباط بالله تعالى بمختلف الوجوه
- التركيز على الأمور المذكورة في أحاديثهم (عليهم السّلام)
- التركيز على الأمور المتقدّمة في الأدعية والزيارات
- جامعية زيارة الجامعة الكبيرة وزيارة يوم الغدير
- التأكيد على عدم شرعية الجور
- إحياء تعاليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته وجميع المعارف الحقة
- اهتمام الأئمّة (عليهم السّلام) بحملة آثارهم وعلماء شيعتهم
- تأكيد الأئمّة (عليهم السّلام) على التفقّه في الدين وعلى إحياء أمرهم
- قيام الحوزات العلمية الشيعية ومميّزاتها
- تحديد الاجتهاد عند الشيعة
- ظهور المرجعيات الدينية بضوابطها الشرعية
- بعض الأحاديث في ضوابط التقليد
- ارتباط الشيعة بمرجعياتهم الدينية عملياً وعاطفياً
- قيادة المرجعية للأُمّة
- العمق التاريخي للمرجعية
- تأكيد الأئمّة (عليهم السّلام) على حقّهم في الخمس
- استقلال التشيّع مادياً
- استقلال الحوزات والمرجعية الدينية عن السلطة
- تميّز الكيان الشيعي
- فرض الكيان الشيعي على أرض الواقع
- تحقيق الوعد الإلهي ببقاء جماعة تلتزم الحقّ وتدعو له
- تميّز دين الإسلام الحقّ ببقاء دعوته وظهور حجّته
- المقارنة بين فترة ما بين المسيح والإسلام ومدّة الغيبة
- الخاتمة
- الفصل الأوّل: في أثر وضوح معالم الإسلام في استقامة منهج الفكر الإنساني
- دافعت ثقافة الإسلام الحقّ عن الأديان السابقة ونبهت لتحريفه
- تنزيه رموز تلك الأديان عمّا نسبته لهم يد التحريف
- تحريف الأديان بنحو مهين
- لو تمّ تحريف الإسلام لضاعت معالم الحقّ على البشرية
- ظهور السلبيات التي أفرزها التحريف
- الفصل الثاني: في إحياء فاجعة الطفّ
- اختلاف الناس في مظاهر التعبير عن شعورهم إزاء الأحداث
- أهمية السواد الأعظم في حمل الدعوة والحفاظ عليها
- موقع الخاصة من الدعوة
- أهمية فعاليات الجمهور في إحياء المناسبات الدينية
- على الخاصة دعم الجمهور في إحياء المناسبات بطريقتهم
- أهمّية الممارسات الصارخة
- الكلام في تطوير طرق إحياء المناسبات
- الوظيفة عند اختلاف وجهات النظر
- دعوى اختصاص أهمّية الإحياء بما إذا كان مقارعة للظلم
- دفع الدعوى المذكورة
- تأكيد رجحان إحياء المناسبات المذكورة في بعض الحالات
- في آداب إحياء المناسبات المذكورة
- لا تكن هذه المناسبات مسرحاً للصراعات
- أهمّية الجهد الفردي مهما تيسّر
- حديث مسمع كردين
- ثبوت الأجر العظيم على إحياء أمرهم (عليهم السّلام)
- شبهة أنّ ذلك يشجع على المعصية
- دفع الشبهة المذكورة
- لا محذور في التركيز على نصوص الأجر والثواب
- رجحان الوعظ والتذكير باهتمام أهل البيت (عليهم السّلام) بالالتزام الديني
- حديث يزيد بن خليفة
- ملحق رقم (١) خطبة الزهراء (عليه السّلام) الكبرى
- مصادر الخطبة
- ملحق رقم (٢) خطبة الزهراء (عليها السّلام) الصغرى
- مصادر الخطبة
- ملحق رقم (٣) خطبة السيّدة زينب (عليها السّلام) في الكوفة
- مصادر الخطبة
- ملحق رقم (٤) خطبة السيّدة زينب (عليها السّلام) في مجلس يزيد في الشام
- مصادر الخطبة
- ملحق رقم (٥) خطبة الإمام زين العابدين (عليه السّلام)
- مصادر الخطبة
- ملحق رقم (٦) حديث زائدة
- المصادر والمراجع






