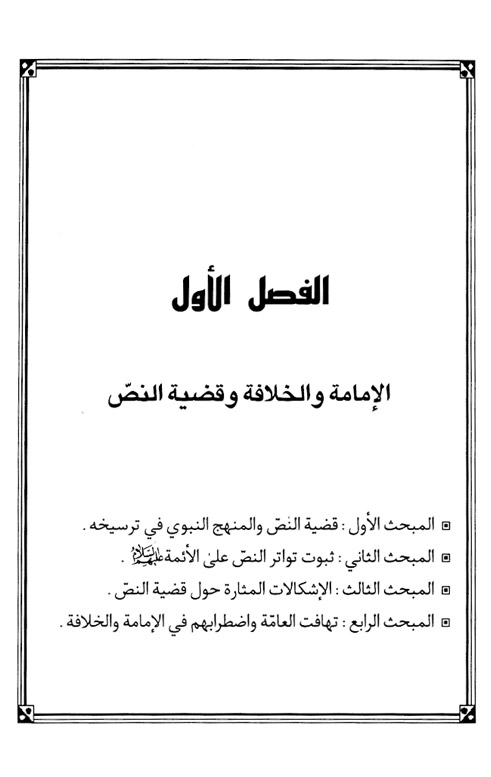مطارحات في الفكر والعقيدة
 44%
44%
 مؤلف: مركز الرسالة
مؤلف: مركز الرسالة
تصنيف: مناظرات وردود
ISBN: 964-319-046-3
الصفحات: 168
- مطارحات في الفكر والعقيدة
- مقدِّمة الكتاب :
- المدخل :
- خطبة لأمير المؤمنين عليهالسلام حول بدء وقوع الفتن :
- أشهر مصادر الخطبة :
- إضاءات حول الخطبة :
- المبحث الأول
- قضيّة النصّ والمنهج النبوي في ترسيخه
- مقدمة
- المطلب الأول
- الإعداد الفكري والتربوي
- للإمام عليّ عليهالسلام وتثبيت أحقيّته بالخلافة
- الرعاية النبوية الخاصة للإمام عليّ عليهالسلام :
- أ ـ المورد الأول :
- ب ـ المورد الثاني :
- المرحلة الثانية :
- المطلب الثاني
- إعداد الاَُمّة وتهيئتها لتولي
- الإمام عليّ عليهالسلام الخلافة وترسيخ النصّ عليه
- المبحث الثاني
- ثبوت تواتر النصّ على الأئمة عليهمالسلام
- أولاً : الطرق الإجمالية لإثبات إمامة الأئمة من أهل البيت عليهمالسلام :
- الحديث الأول :
- مصادره :
- اتهام زرارة بعدم معرفته لإمام زمانه :
- الردّ على هذا الاتهام وبيان زيفه :
- الحديث الثاني :
- مصادره :
- ثانياً : تواتر النصّ عند الشيعة :
- المبحث الثالث
- الإشكالات المثارة حول قضية النصّ
- الإشكال الأول :
- جواب الإشكال الأول :
- الإشكال الثاني :
- جواب الإشكال الثاني :
- الإشكال الثالث :
- جواب الإشكال الثالث :
- الإشكال الرابع :
- جواب الإشكال الرابع :
- تبرّم أمير المؤمنين عليهالسلام من خرافة الشورى :
- الإشكال الخامس :
- جواب الإشكال الخامس :
- الإشكال السادس :
- جواب الإشكال السادس :
- الإشكال السابع :
- جواب الإشكال السابع :
- ثانياً : حجة المصاهرة :
- ثالثاً : حجة التسمية :
- رابعاً : حجة المعاتبة :
- الإشكال الثامن :
- جواب الإشكال الثامن :
- الإشكال التاسع :
- جواب الإشكال التاسع :
- المبحث الرابع
- تهافت العامّة واضطرابهم في الإمامة والخلافة
- المبحث الأول
- مفتريات حول تحريف القرآن الكريم
- كلمة موجزة عن كتب الحديث عند الفريقين :
- أكاذيب حول كتاب الكافي بشأن شبهة التحريف :
- رد هذه الاكاذيب ومعالجة تلك الشبهة :
- مناقشة أصل الشبهة واثبات تهافت حججهم :
- الحجة الاُولى : رواية الكليني لروايات التحريف :
- مناقشة الحجة الاُولى :
- أما الرواية التي شُنَّع بها على الكافي والشيعة أيضاً
- نظائر رواية الكافي في كتب العامّة :
- عودة إلى بعض روايات الكافي :
- الحجة الثانية : احتجاجهم بعناوين أبواب الكافي :
- جواب الحجة الثانية :
- روايات التحريف في أهم كتب العامّة :
- أمثلة أضغاث الباطل في كتب الصحاح :
- المبحث الثاني
- البَدَاءُ وعلم الله تعالى
- الافتراء على الشيعة بتعريف البَدَاء
- تزييف هذا التعريف وبيان وقاحة مفتريه :
- نفي الجهل عن ساحته تعالى :
- علم الله تعالى عند الشيعة الإمامية :
- توضيح في اطلاق البداء على الله تعالى :
- حسبنا كتاب الله :
- حديث الأريكة :
- إتلاف الأحاديث :
- موقف عمر من السُنّة المطهّرة :
- موقف عثمان ومعاوية من السُنّة الشريفة :
- إدراك العامّة فداحة المواقف السابقة :
- مخالفتهم للسُنّة العملية :
- نتيجة منع الحديث :
- المحتويات