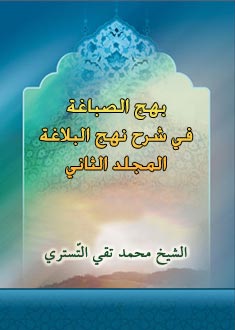و قال أبو طالب :
أمين حبيب في العباد مسوّم
بخاتم ربّ قاهر في الخواتم
يرى الناس برهانا عليه و هيبة
و ما جاهل في قومه مثل عالم
و لابن ظفر النحوي اللغوي كتاب مترجم ب ( خير البشر لخير البشر ) ،
ذكر فيه الارهاصات الّتي كانت بين يدي ظهور النبيّ صلى اللّه عليه و آله ١ .
و في ( كنز الكراجكي ) في التّوراة مكتوب : « إذا جاءت الأمّة الأخيرة تتّبع راكب البعير يسبّحون الربّ تسبيحا جديدا » و راكب البعير هو نبيّنا ، و الامّة الأخيرة أمّته ٢ .
و فيه : في السفر الخامس من التّوراة : « الربّ ظهر فتجلّى على سينين ،
و أشرف على جبل ساعير ، و أشرف من جبل فاران » و جبل فاران جبل مكّة ،
و ظهور الربّ ظهور أمره ٣ .
و فيه و في الإنجيل : « ابن البشير ذاهب ، و الفارقليطا آت من بعده » ٤ و من
ـــــــــــــــــ
( ١ ) المعارف لابن قتيبة : ٦٠ .
( ٢ ) كنز الفوائد للكراجكي : ٩١ ، و عيون الأخبار للصدوق ١ : ١٣١ بفرق يسير باللفظ ، و الاحتجاج للطبرسي : ٤١٩ عن الرضا عليه السّلام عن التّوراة .
( ٣ ) كنز الفوائد للكراجكي : ٩١ ، و جاء في التّوراة الموجودة في سفر التثنية ، و هو السفر الخامس ، الإصحاح ٣٣ الآية ٢ و لفظه : « فقال جاء الرب من سيناء و أشرق لهم من سعير و تلألأ من جبل فاران » .
( ٤ ) كنز الفوائد للكراجكي : ٩١ ، و عيون الأخبار للصدوق ١ : ١٣٢ بفرق يسير ، و الاحتجاج للطبرسي : ٤٢٠ عن الرضا عليه السّلام عن الانجيل ، و سيرة لابن هشام ١ : ٢١٥ ، و لفظة ( فارقليط ) معربة من اليونانية . و جاء هذا اللفظ في مواضع من الأصل اليوناني من العهد الجديد ، و معنى ما ذكر في متن الكتاب جاء في إنجيل يوحنا ،
الإصحاح ١٤ الآية ١٦ و ٢٦ ، و الاصحاح ١٥ الآية ٢٦ ، و الإصحاح ١٦ الآية ٧ . أمّا هذه الكلمة فجاءت في الترجمات العربية القديمة ( الفارقليط ) ، و في الترجمات العربية الجديدة ( المعزّي ) ، و أمّا معناه في اللغة اليونانية ( المستغاث ، المغيث ، الشفيع ، وكيل الدعاوى ) ، كما قاله في : ١٠٧٢ ، و غيره من كتب اللغة . و الظاهر أنّ ترجمة هذه الكلمة في ترجمات الكتاب المقدّس بمرادفات ( المعزّي ، المسلّي ، المريح ) خطأ من المترجمين السابقين ، كما صرّح بكونه خطأ في ١٤ : ٢٢٣ ، و لا يسع المقام
 0%
0%
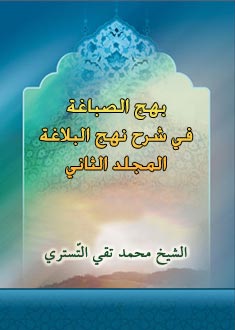 مؤلف: الشيخ محمد تقي التّستري
مؤلف: الشيخ محمد تقي التّستري