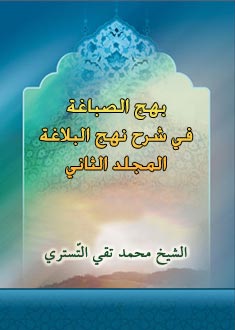و في ( السيرة ) : عن أبي عياش قال : قال لي النبيّ صلى اللّه عليه و آله في غزوة ذي قرد :
« لو أعطيت هذا الفرس رجلا هو أفرس منك ، فقلت : أنا أفرس الناس . فو اللّه ما جرى بي خمسين ذراعا حتّى طرحني ، فعجبت أنّ النبيّ صلى اللّه عليه و آله يقول : لو أعطيته أفرس منك ، و أنا أقول : أنا أفرس الناس ١ .
و فيه أيضا : و أقبل النبيّ صلى اللّه عليه و آله في المسلمين ، فإذا مسجّى ببردة أبي قتادة ، فاسترجع الناس و قالوا : قتل أبو قتادة . فقال النبيّ صلى اللّه عليه و آله : ليس بأبي قتادة ، و لكنّه قتيل لأبي قتادة ، وضع عليه برده لتعرفوا أنّه برده ٢ .
و فيه أيضا بعد ذكر إغارة عيينية على لقاح النبيّ صلى اللّه عليه و آله و فيها رجل من غفار ، فقتلوا الرجل ، و احتملوا المرأة في اللقاح قال : و أقبلت امرأة الغفاري على ناقة من إبل النبيّ صلى اللّه عليه و آله و قالت : نذرت للّه أن أنحرها إن نجّاني اللّه عليها .
فتبسّم النبيّ صلى اللّه عليه و آله ثمّ قال : بئس ماجزيتها أن حملك اللّه عليها و نجّاك بها ثمّ تنحرينها ، إنّه لا نذر في معصية اللّه ، و لا في ما لا تملكين ، إنّما هي ناقة من إبلي ،
فارجعي إلى أهلك على بركة اللّه ٣ .
« و حكمه العدل » أعطى النبيّ صلى اللّه عليه و آله ليهود خيبر أرضها و نخلها بالمناصفة ، فلمّا أدركت الثمرة بعث عبد اللّه بن رواحة ، فقوّم عليهم و خرص ،
فقال لهم : إمّا أن تأخذوه و تعطوني نصف التمر ، و إمّا أخذه و أعطيكم نصف التمر . فقالوا : بهذا قامت السماوات و الأرض ٤ .
و روى ( الكافي ) أنّ رجلا من الأنصارى و رجلا من ثقيف أتيا النبيّ صلى اللّه عليه و آله ،
فقال الثقفي : يا رسول اللّه حاجتي . فقال صلى اللّه عليه و آله : سبقك أخوك الأنصاري . فقال : يا
ـــــــــــــــــ
( ١ ) سيرة ابن هشام ٣ : ١٧٦ و النقل بتصرف في اللفظ .
( ٢ ) سيرة ابن هشام ٣ : ١٧٦ و النقل بتصرف في اللفظ .
( ٣ ) السيرة النبوية لابن هشام ٣ : ١٧٨ و النقل بتصرف .
( ٤ ) أخرجه أحمد بطريقين في مسنده ٢ : ٢٤ ، و ٣ : ٣٦٧ و غيره .
 0%
0%
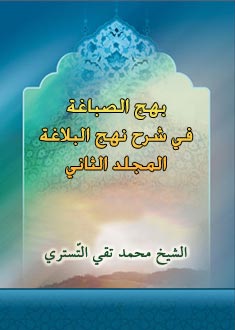 مؤلف: الشيخ محمد تقي التّستري
مؤلف: الشيخ محمد تقي التّستري