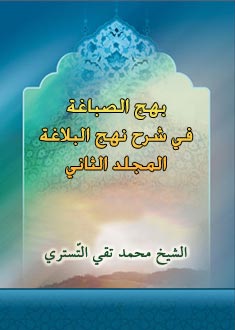حقّا ، و لا يقول الكلمة إلاّ أهل الباطل ؟ و أمّا أهل الحقّ ، فإنّما يقولون ما قاله عليه السّلام في موضع آخر : « المنية و لا الدنية » ١ ، و ما قاله الحسين عليه السّلام يوم الطّف :
الموت خير من ركوب العار
و العار أولى من دخول النار
و اللّه ما هذا و هذا جاري
٢ « كأنّكم تريدون أنّ تكفئوا » من : كفأت الإناء : كببته و قلبته .
« الإسلام على وجهه » .
« إنتهاكا » افتعال من ( نهك ) ، و ليس بانفعال ، فإنّه لو كان لكان من ( تهك ) و ليس لنا تهك .
« لحريمه » قال الجوهري : انتهاك الحرمة : تناولها بما لا يحل ٣ .
« و نقضا لميثاقه » قال تعالى في بني إسرائيل : فبما نقضهم ميثاقهم لعنّاهم و جعلنا قلوبهم قاسية . . . ٤ .
« الّذي » وصف للإسلام ، و جعله ابن ميثم ٥ و صفا لميثاق ، و مع كونه خلاف الظاهر لعدم الإتيان بوصف لحريم يمنع منه قوله بعد : « و أنّكم إن لجأتم إلى غيره » .
« وضعه اللّه لكم حرما في أرضه » فكما أنّ الحرم صيده و شجره حرام ،
المسلم ماله و دمه حرام ، قال النبيّ صلى اللّه عليه و آله : أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا : لا إله إلاّ اللّه ، فإذا قالوا : لا إله إلاّ اللّه عصموا منّي دماءهم ٦ .
ـــــــــــــــــ
( ١ ) نهج البلاغة للشريف الرضي ٤ : ٩٤ الحكمة ٣٩٦ ، و ذكره بعنوان المثل الميداني في مجمع الأمثال ٢ : ٣٠٣ .
( ٢ ) المناقب لابن شهر آشوب ٤ : ٦٨ .
( ٣ ) صحاح اللغة للجوهري ٣ : ١٦١٣ مادة ( نهك ) .
( ٤ ) المائدة : ١٣ .
( ٥ ) شرح ابن ميثم ٤ : ٣٠٣ .
( ٦ ) أخرجه مسلم في صحيحه ١ : ٥٢ ح ٣٥ ، و الترمذي في سننه ٥ : ٤٣٩ ح ٣٣٤١ ، و ابن ماجه في سننه ٢ : ١٢٩٥.
 0%
0%
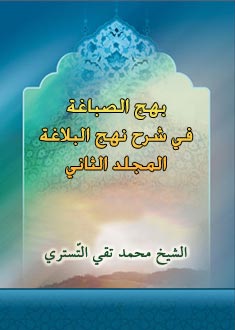 مؤلف: الشيخ محمد تقي التّستري
مؤلف: الشيخ محمد تقي التّستري