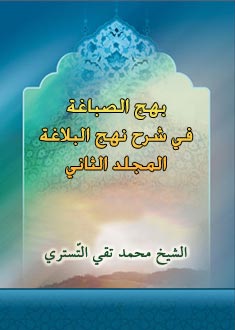و الضحى و الليل إذا سجى ما ودّعك ربّك و ما قلى و للآخرة خير لك من الأولى و لسوف يعطيك ربّك فترضى ١ .
و قوله عليه السّلام فيهما : « و اجزه مضاعفات الخير من فضلك » إنّا أعطيناك الكوثر . فصلّ لربّك و انحر . إنّ شانئك هو الأبتر ٢ .
فيهما : « اللّهمّ أعل على بناء البانين بناءه » هو الّذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحقّ ليظهره على الدين كلّه و لو كره المشركون ٣ .
و روى عن النبيّ صلى اللّه عليه و آله : إنّما مثلي و مثل الأنبياء قبلي كرجل بني دارا فأكملها و أحسنها إلاّ موضع لبنة ، فجعل الناس يدخلون و يعجبون بها ،
و يقولون : هلاّ وضعت هذه اللبنة . فأنا اللبنة ، و أنا خاتم النبييّن ٤ .
في الأوّل : « و أكرم لديك منزلته » هكذا في ( المصرية ) و الصواب : ( منزله ) كما في ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطّية ) ٥ .
و في الثاني : « و أكرم لديك منزلته » قال الجوهري : النزل : ما يهيّأ للنزيل ٦ .
« و شرّف عندك منزلته » هكذا في ( المصرية ) ٧ ، و الصواب : ( منزله ) ،
و في الدعاء : « وابعثه المقام المحمود » ٨ ، و عنه صلى اللّه عليه و آله : لواء الحمد بيدي » ٩ .
ـــــــــــــــــ
( ١ ) الضحى : ١ ٥ .
( ٢ ) الكوثر : ١ ٣ .
( ٣ ) الصف : ٩ .
( ٤ ) صحيح مسلم ٤ : ١٧٩٠ ح ٢٠ ٢٣ ، و سنن الترمذي ٥ : ٥٨٦ ح ٣٦١٣ ، و غيرهما .
( ٥ ) في شرح ابن أبي الحديد ٢ : ٥١ و شرح ابن ميثم ٢ : ١٩٦ « منزلته » أيضا .
( ٦ ) صحاح اللغة للجوهري ٥ : ١٨٢٨ مادة ( نزل ) .
( ٧ ) و كذا في شرح ابن أبي الحديد ٢ : ٢١٩ ، و شرح ابن ميثم ٣ : ٣٣ كما في المصرية .
( ٨ ) نقله في ضمن زيارة ابن طاووس في جمال الأسبوع : ٢٩ بلفظ : « و ابعثه مقاما محمودا » .
( ٩ ) أخرجه الفرات الكوفي في تفسيره : ٢٠٦ ، و الترمذي بطريقين في سننه ٥ : ٥٨٦ ح ٣٦١٣ ، و غيرهما كثيرا لكن في الباب أحاديث قول علي : إنّ النبيّ صلى اللّه عليه و آله صاحب لواء الحمد ، و حامله علي عليه السّلام . جمع بعض طرقه المجلسي في البحار ٨ : ١ الباب ١٨ .
 0%
0%
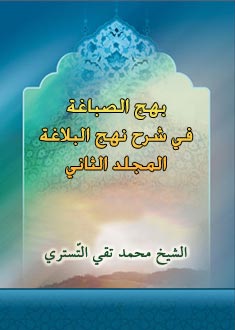 مؤلف: الشيخ محمد تقي التّستري
مؤلف: الشيخ محمد تقي التّستري