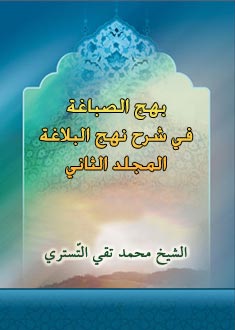شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي WWW.ALHASSANAIN.COM كتاب بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة المجلد الثاني الشيخ محمد تقي التّستري
شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي
أطعت اللّه تعالى فأنت منّا أهل البيت و زاد في ( رواية ابن الجهم ) : و قال عليه السّلام له :
يابن الجهم من خالف دين اللّه فابرأ منه كائنا من كان ، من أيّ قبيلة كان ، و من عادى اللّه فلا تواله كائنا من كان ، و من أيّ قبيلة كان . فقلت : يابن رسول اللّه ،
و من الّذي يعادي اللّه ؟ قال : من يعصيه ١ .
و عن النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلم قال لبني عبد المطلّب ، و بني هاشم : إنّي رسول اللّه إليكم ، و إنّي شفيق عليكم و إنّ لي عملي ، و لكلّ رجل منكم عمله ، لا تقولوا : إنّ محمّدا منّا ، و سندخل مدخله ، فلا و اللّه ما أوليائي منكم و لا من غيركم يا بني عبد المطلب إلاّ المتّقون ، إلاّ فلا أعرفكم يوم القيامة تأتون تحملون الدّنيا على ظهوركم ، و يأتون الناس يحملون الآخرة ، ألا إنّي قد أعذرت إليكم فيما بيني و بينكم ، و فيما بيني و بين اللّه عزّ و جلّ فيكم ٢ .
و قال : يا بني عبد المطّلب إيتوني بأعمالكم لا بأحسابكم و أنسابكم ، قال عزّ و جلّ : فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ و لا يتساءلون ٣ .
و عن الرضا عليه السّلام : قال عليّ بن الحسين عليه السّلام : لمحسننا كفلان من الأجر ،
و لمسيئنا ضعفان من العذاب ٤ .
و عن الكاظم عليه السّلام : أنّ إسماعيل قال لأبيه الصادق عليه السّلام : ما تقول في المذنب منّا و من غيرنا ؟ فقال عليه السّلام : ليس بأمانيكم و لا أمانيّ أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به . . . ٥ .
و عن موسى الرّازي : قال رجل للرضا عليه السّلام : و اللّه ما على وجه الأرض
ـــــــــــــــــ
( ١ ) أخرج الأحاديث الثلاثة الصدوق في عيون الأخبار للصدوق ٢ : ٢٣٤ ، ٢٣٦ ح ١ ، ٤ ، ٦ و النقل بتصرف .
( ٢ ) الكافي للكليني ٨ : ١٨٢ ح ٢٠٥ ، و صفات الشيعة للصدوق : ٥ ح ٨ .
( ٣ ) عيون الأخبار للصدوق ٢ : ٢٣٧ ح ٧ ، و الآية ١٠١ من سورة ( المؤمنون ) .
( ٤ ) روى هذا المعنى الطبرسي في مجمع البيان ٨ : ٣٥٤ عن السجاد عليه السّلام و زيد بن علي .
( ٥ ) عيون الأخبار للصدوق ٢ : ٢٣٦ ح ٥ ، و الآية ١٢٣ من سورة النساء .
 0%
0%
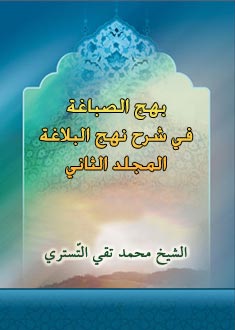 مؤلف: الشيخ محمد تقي التّستري
مؤلف: الشيخ محمد تقي التّستري