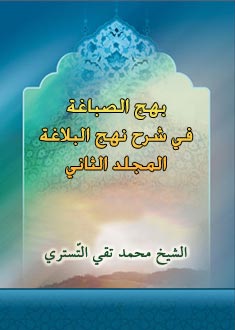و في المسلمين من هو أعلم منه فهو ضالّ متكلّف ١ .
و روى الخطيب في ليث بن الفرج عن النّبيّ صلى اللّه عليه و آله قال : ليضربنّ النّاس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة . . . ٢ و مراده صلى اللّه عليه و آله بعالم المدينة الأئمّة من أهل بيته ، و الدّليل عليه قوله صلى اللّه عليه و آله : « عالم المدينة » دون علماء المدينة ، و في كلّ زمان لم يكن أكثر من إمام .
و شاهد عدم اقتفائهم أثر النبي كما ذكره عليه السّلام ما قالوه في أبي الغادية الجهني قاتل عمّار ، قال ابن عبد البرّ في ( استيعابه ) : سمع من النّبيّ صلى اللّه عليه و آله قوله :
لا ترجعوا بعدي كفّارا يضرب بعضكم رقاب بعض . و كان محبّا في عثمان ،
و هو قاتل عمّار بن ياسر . و كان إذا استأذن على معاوية و غيره يقول : قاتل عمّار بالباب و كان يصف قتله له إذا سئل عنه لا يباليه ، و في قصّته عجب عند أهل العلم ، روى عن النّبي صلى اللّه عليه و آله ما ذكرنا أنّه سمعه منه ، ثمّ قتل عمّارا ٣ .
قلت : و أعجب من أمر أبي الغادية أمر جميع هؤلاء المدّعين للدّين ،
و العلم و اليقين ، يجمعون بين القول بجلالة عمّار ، و ولاية عثمان ، فالرّجل و إن اتّبع هواه إلاّ أنّه حمله محبّته لعثمان على ترك قول النّبيّ صلى اللّه عليه و آله سلما من الجمع من التّضاد و القول بالمحال .
و كذلك من قدّم منهم فعل عمر على قول النّبيّ صلى اللّه عليه و آله ، فرأى رجل منهم معاوية على منبر النّبي صلى اللّه عليه و آله يخطب فسلّ سيفه و ذهب إليه ليقتله ، فقيل له : لم ؟
قال : لأنّي سمعت النّبي صلى اللّه عليه و آله يقول : « إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه » ٤ .
فقالوا له : أتدري من ولاّه ؟ قال : لا . قالوا : عمر . قال : سمعا و طاعة لعمر .
ـــــــــــــــــ
( ١ ) الكافي للكليني ٥ : ٢٣ ح ١ ، و الاحتجاج للطبرسي : ٣٦٢ .
( ٢ ) تاريخ بغداد للخطيب ١٣ : ١٦ .
( ٣ ) الاستيعاب ٤ : ١٥١ .
( ٤ ) حديث النّبي صلى اللّه عليه و آله أورده من عدّة طرق الفيروز آبادي في السبعة من السلف : ١٩٩ ٢٠١ .
 0%
0%
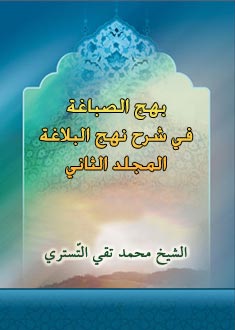 مؤلف: الشيخ محمد تقي التّستري
مؤلف: الشيخ محمد تقي التّستري