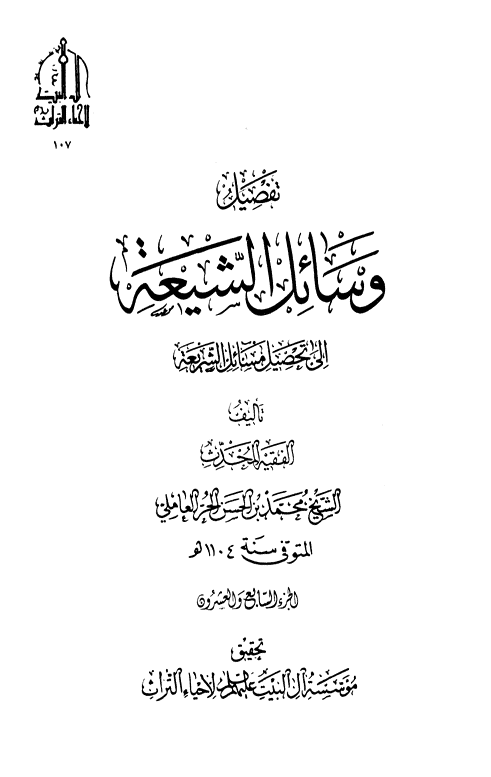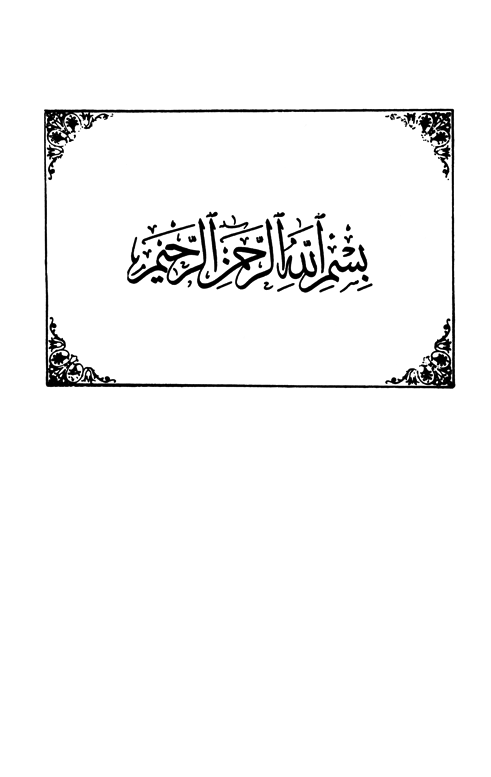وسائل الشيعة الجزء ٢٧
 0%
0%
 مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 424

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 424
المشاهدات: 163545
تحميل: 7120
توضيحات:
- كتاب القضاء
- تفصيل الأبواب
- أبواب صفات القاضي، وما يجوز أن يقضي به 1 - باب أنه يشترط فيه الإِيمان والعدالة، فلا يجوز الترافع إلى قضاة الجور وحكامهم، إلّا مع التقية والخوف، ولا يمضي حكمهم وإن وافق الحق
- 2 - باب أن المرأة لا تولى القضاء. 3 - باب أنه لا يجوز لأحد ان يحكم إلّا الإِمام، أو من يروي حكم الإِمام، فيحكم به( * )
- 4 - باب عدم جواز القضاء والإِفتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين ( عليهمالسلام )
- 5 - باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة، ووجوب نقض الحكم مع ظهور الخطأ
- 6 - باب عدم جواز القضاء والحكم، بالرأي، والاجتهاد، والمقاييس، ونحوها من الاستنباطات الظنية في نفس الأحكام الشرعية( * )
- 7 - باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى المعصومين ( عليهمالسلام ) ( * )
- 8 - باب وجوب العمل بأحاديث النبي ( صلىاللهعليهوآله ) والأئمة ( عليهمالسلام ) ، المنقولة في الكتب المعتمدة وروايتها، وصحتها، وثبوتها
- 9 - باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة، وكيفية العمل بها
- 10 - باب عدم جواز تقليد غير المعصوم ( عليهالسلام ) فيما يقول برأيه، وفيما لا يعمل فيه بنص عنهم ( عليهمالسلام )
- 11 - باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة، فيما رووه عن الأئمة ( عليهمالسلام ) من أحكام الشريعة، لا فيما يقولونه برأيهم
- 12 - باب وجوب* التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى، والعمل في كل مسألة نظرية لم يعلم حكمها بنص منهم ( عليهمالسلام )
- 13 - باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن، إلّا بعد معرفة تفسيرها من الأئمة ( عليهمالسلام )
- 14 - باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كلام النبي ( صلىاللهعليهوآله ) ، المروي عن غير جهة الأئمّة ( عليهمالسلام ) ما لم يعلم تفسيره منهم
- أبواب آداب القاضي 1 - باب جملة منها
- 2 - باب كراهة القضاء في حال الغضب، وعدم جواز الحكم من غير تأمّل
- 3 - باب استحباب مساواة القاضي بين الخصوم في الإِشارة، والنظر، والمجلس، وكراهة ضيافة أحد الخصمين دون الآخر
- 4 - باب أنّه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة، ولا في حضور من هو أعلم منه، ولا قبل سماع كلام الخصمين، ويجب عليه إنصاف الناس حتى من نفسه
- 5 - باب أنه يستحب للإِنسان أن يقوم عن يمين خصمه، ويستحب للقاضي أن يقدم الذي عن يمين خصمه بالكلام
- 6 - باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور*
- 7 - باب أن المفتي اذا أخطا أثم، وضمن
- 8 - باب تحريم الرشوة في الحكم، والرزق من السلطان على القضاء
- 9 - باب تحريم الحيف في الحكم، والميل مع أحد الخصمين
- 10 - باب أن أرش خطأ القاضي في دم، أو قطع على بيت المال
- 11 - باب جواز القضاء والحكم في غير الدم بالتقية مع الضرورة والخوف، واستحباب اختيار السكوت
- 12 - باب تحريم الحكم بالجور
- أبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى 1 - باب أن الحكم بالبينة واليمين
- 2 - باب أنه لا يحل المال لمن انكر حقا، أو ادعىٰ باطلاً، وإن حكم له به القاضي، أو المعصوم ببينة، أو يمين
- 3 - باب أنَّ البيّنة على المدعي، واليمين على المدعى عليه في المال، وحكم دعوى القتل والجرح، وأنّ بينة المدعى عليه لا تقبل مع التعارض وغيره
- 4 - باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يردّ، وعدم ثبوت الدعوى على الميت، إلّا ببينة ويمين على بقاء الحق
- 5 - باب أن الزنا لا يثبت إلّا بأربعة شهداء، وسائر الحقوق تثبت بشاهدين
- 6 - باب أنّ الحاكم ان عرف عدالة الشهود حكم، وإن عرف فسقهم لم يحكم، وإن اشتبه عليه سأل عنهم، حتى يعرفهم شاهدان، أو يحصل الشياع، وكيفية السؤال والتعريف، واستحباب الترغيب في الصلح
- 7 - باب أن المدعي اذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر، فإن رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى، وإن نكل بطلت
- 8 - باب أن المدعي إذا أقام البينة، فلا يمين عليه معها إلّا فيما استثنى
- 9 - باب أنّ من رضي باليمين فحلف له، فلا دعوى له بعد اليمين، وإن كانت له بينة*
- 10 - باب أن المدعي إذا استحلف المنكر فحلف، فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً، وكذا إذا احتسب حقه، وإلّا فله الاقتصاص بقدر حقه
- 11 - باب أنه يقضى بالحبس في الدين ونحوه
- 12 - باب حكم تعارض البينتين، وما ترجح به إحداهما، وما يحكم به عند فقد الترجيح
- 13 - باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة، وجملة من مواقعها، وكيفيتها
- 14 - باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد ويمين المدعي، لا في الهلال والطلاق ونحوهما
- 15 - باب ثبوت دعوى المالية بشهادة رجل وامرأتين، وبشهادة امرأتين ويمين
- 16 - باب حكم من ادعى على آخر الفاً، وأقام بينة، ثم ادعى خمسمائة، ثم ثلاثمائة، ثمّ مائتين، وأقام بينة بالجميع، فادعى المدعى عليه التداخل، وأنكر المدعي. 17 - باب أنه إذا كان جماعة جلوساً، وسطهم كيس، فقالوا كلهم: ليس لنا، وادعاه واحد حكم له به
- 18 - باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة
- 19 - باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة، واستقصاء سؤالهم عن مشخصات القضية، فان اختلفوا ردت شهادتهم، وعدم وجوب التفريق
- 20 - باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة واستقصاء سؤالهم وابطال دعواهم ان اختلفوا، وعدم وجوب التفريق
- 21 - باب جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن أمير المؤمنين ( عليهالسلام )
- 22 - باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم
- 23 - باب حكم ما لو ادعى الاب أو غيره أنه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم، هل يقبل بلا بينة أم لا ؟
- 24 - باب أنه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعي مع احتمال الصدق، لا مع عدم احتماله
- 25 - باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها، وجواز الشهادة لصاحب اليد بالملك، وأنه لا يجب على القاضي تتبع أحكام من قبله، وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت
- 26 - باب كيفية الحكم على الغائب، وحكم القبالة* المودعة لرجلين
- 27 - باب ان القاضي اذا ترافع اليه أهل الكتاب فله أن يحكم بينهم بحكم الاسلام، وله أن يتركهم
- 28 - باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض الى قاض
- 29 - باب كراهة التغليظ في اليمين، بأن يحلف عند قبر النبي ( صلىاللهعليهوآله ) في أقل من نصاب القطع، وجواز تغليظ اليمين على الكافر بمكان يعتقد شرفه
- 30 - باب انه لا يمين على المنكر في الحدود، ولا يحبس المحدود إلا فيما استثني، ولا يضمن صاحب الحمام الثياب 31 - باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم، والحد الذي يجري فيه الاحكام على الصبيان والبنات
- 32 - باب من يجوز حبسه
- 33 - باب كيفية إحلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة، والحكم بالنكول، وجواز تغليظ اليمين
- 34 - باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة
- 35 - باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها، وما يثبت به الحقوق من الشهود 36 - باب أنه يجوز للولد ان يخاصم والده إذا ظلمه، ولا يرفع صوته على صوته
- كتاب الشهادات
- 1 - باب وجوب الإِجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة
- 2 - باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها
- 3 - باب وجوب اقامة الشهادة للعامة، إلا ان يخاف الضيم على المؤمن
- 4 - باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي، إذا كانت حقاً
- 5 - باب أن من علم بشهادة ولم يشهد عليها، جاز له أن يشهد بها ولم يجب عليه الا أن يخاف ضياع حق المظلوم
- 6 - باب تحريم الرجوع عن الشهادة إذا كان حقاً
- 7 - باب وجوب الشهادة بالوقف إذا اشهده باسم وكيل ثم مات أو تغير وتولى غيره 8 - باب أنه يجوز للإِنسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه، إذا حصل له العلم وأمن التزوير ولم يبق عنده شك، وإلّا لم يجز
- 9 - باب تحريم شهادة الزور
- 10 - باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم، وإن كان بعده غرّموا
- 11 - باب أن الشاهد اذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال، إلا أن يكون المال قائماً بعينه فيرد على صاحبه
- 12 - باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجعوا، أو رجع أحدهم بعد الرجم
- 13 - باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق، فأنكر بعدما تزوجت، أو بموت فظهر حياته
- 14 - باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة، ثم رجعا بعد القطع، ضمنا دية اليد، فان شهدا على آخر بالسرقة لم يقبل
- 15 - باب أن شاهد الزور يضرب حداً بقدر ما يراه الإِمام، ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف، ولا تقبل شهادته إلّا أن يتوب
- 16 - باب أن المرأة اذا نسيت الشهادة فذكرتها أخرى فذكرت، وجب عليها اقامتها وقبلت
- 17 - باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك، وعدم المشارك في الارث، والشهادة بالعلم ونفيه والحلف عليهما، والشهادة بملكية صاحب اليد
- 18 - باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور، وجواز دفع الضرر بها عن النفس وعن المؤمن وعن العرض
- 19 - باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر مع خوف ظلم الغريم له
- 20 - باب أنه لا تجوز الشهادة إلّا بعلم
- 21 - باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ، وشهد بها بعده قبلت
- 22 - باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ
- 23 - باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما
- 24 - باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز*
- 25 - باب جواز شهادة المرأة لزوجها، والرجل لزوجته
- 26 - باب جواز شهادة الولد لوالده وبالعكس، والأخ لأخيه، لا الولد على والده
- 27 - باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه، وقبولها في غيره
- 28 - باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما إلا فيما هو وصي فيه
- 29 - باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر، وجوازها لغيره، وله بعد مفارقته، وجواز شهادة الضيف
- 30 - باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم
- 31 - باب عدم قبول شهادة ولد الزنا
- 32 - باب جملة ممّن لا تقبل شهادتهم
- 33 - باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج، وكل مقامر وفاعل الغناء ومستمعه
- 34 - باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته، وقبول شهادة المكاري والجمال والملاح مع الصلاح
- 35 - باب عدم قبول شهادة السائل بكفه
- 36 - باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة وعدم قبولها قبلها
- 37 - باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها
- 38 - باب قبول شهادة المسلم على الكافر، وعدم جواز قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميا عدا ما استثنى
- 39 - باب أن الكافر إذا اُشهد على شهادة ثم أسلم فشهد بها قبلت
- 40 - باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية في الضرورة
- 41 - باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة
- 42 - باب قبول شهادة الأعمى والأصم فيما يمكنهما العلم به
- 43 - باب أنه لا بد في الشهادة على المرأة من أن تعرف أو يحضر من يعرفها أن تسفر عن وجهها فينظر إليها الشاهد
- 44 - باب جواز الشهادة على الشهادة إذا كان شاهد الأصل لا يمكنه الحضور وإن كان حيا بالبلد، وأنه لا بد من شاهدين على شاهد الأصل، وعدم قبول شهادة الفرع على الفرع
- 45 - باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود
- 46 - باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع
- 47 - باب قبول شهادة الخصي ومن ذهب بعض أعضائه
- 48 - باب حكم شهادة الشهود بالحدود إذا لم يعرفها البائع وعرفت من غيره
- 49 - باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنا بشاهدين، وعدم ثبوت الزنا بأقل من أربعة
- 50 - باب أنه يكره للإِنسان أن يكون أول الشهود في الزنا بل ينبغي تأخره
- 51 - باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها رجلان عدلان، وإن شهد له ألف بالبراءة، ويحكم على الساحر بشاهدين
- 52 - باب أن بعض الورثة اذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه، إلا أن يشهد رجلان عدلان فيجوز على الجميع
- 53 - باب كراهة تحمل الشهادة مع ظن عدم قبولها عند الأداء
- 54 - باب قبول شهادة اللاعب بالحمام، وصاحب السباق المراهن عليه مع عدم الفسق
- 55 - باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة
- 56 - باب استحباب الإِشهاد على الأرض اذا دفن فيها شيء، والإِشهاد على القرض وغيره، والشهادة للميت بالخير
- الفهرس