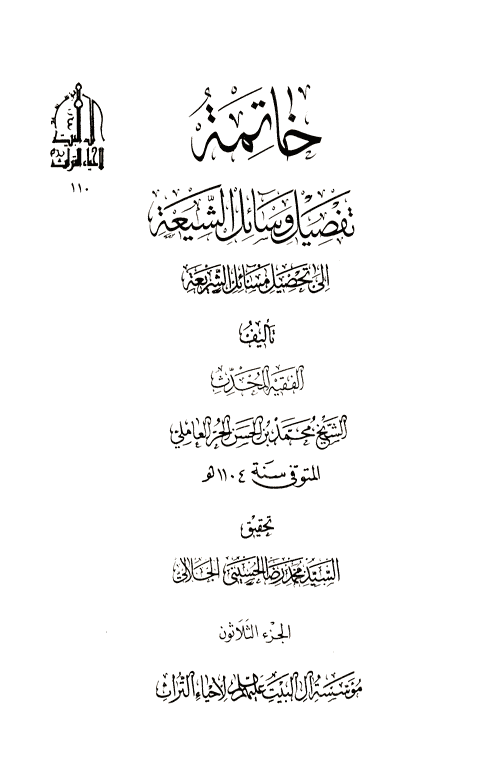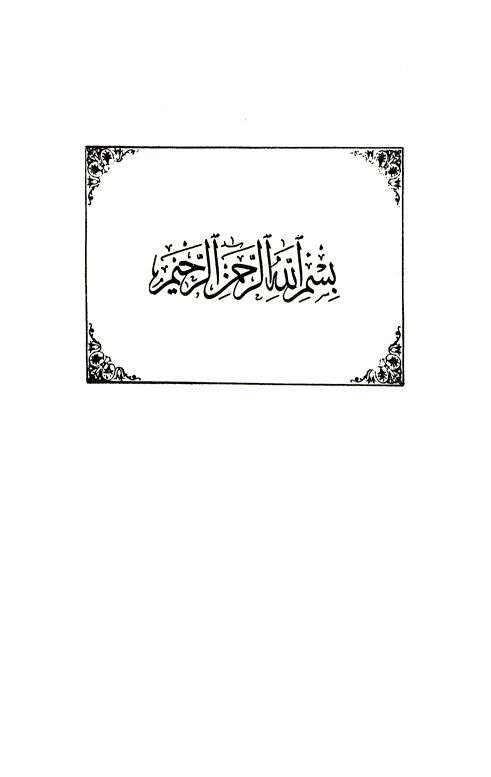إلّا أن يكون الخطأ في نُسخته
فقد خرجنا من عهدته، وقد أشرنا إلى كثير منه في الهوامش، عند مخالفة ما أثبته لما جاء في مصادره في النسخ التي راجعناها، ويقرب - في النظر - أن ما أثبتته هو الصحيح.
أو يكون قد أخطأنا فيه
مما زاغت عنه الباصرة، ولا ندّعي العصمة ولا الإِحاطة الكاملة لما في هذا العمل من السعة والطول، ولعلّ أهم الأسباب في حدوث كثير من ذلك هو تعدد مجالات العمل، من الطبع بالصفّ الالكتروني في بيروت، وتعدد الايدي في مراحل العمل، وما يعرض على الكتاب في مراحل الطبع والإخراج: وقد قيل: إن الخطأ المطبعيّ من قبيل « لزوم ما لايلزم ».
ويكفي فخراً أن تكون الأخطاءُ معدودةً بالنسبة إلى حجم الكتاب الذي يتجاوز ( خمسة عشر ألف ) صفحة، وبالنسبة إلى ما يوجد من الطبعات السابقة للكتاب، وبالنسبة الى ما يصدر من مطبوعات حديثة مليئة بالأخطاء، على صغر حجمها.
وأمّا ما يَرْتبطُ بهذا الجُزْء:
فهو يحتوي على ( خاتمة الوسائل ) بفوائده الاثني عشر.
وهو من عملي الخاصّ، قمتُ بتحقيقه على ثلاث نُسخٍ:
الاُولى:
المصوّرة على نسخة خطّ المؤلّفرحمهالله
، وهي النسخة الثالثة التي كتبها، وتعتبر مبيّضة الكتاب، وقد ذكرناها بعنوان (الاصل).
الثانية:
المصحّحة على نسخة المؤلف، بمقابلة جمع من اعلام النجف الأشرف وقد كتب التصحيحات سماحة الحجة المرحوم السيّد محمّد الرضوي نجل أية الله الحجة المقدّس السيد مرتضى الكشميري رحمة الله عليه.
وقد سجلت التصحيحات على الحجرية المطبوعة سنة (١٢٨٨) بطهران، والنسخة من محفوظات مكتبتنا.
 0%
0%
 مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي